لم يتقدم الفكر الإنساني الا بالخروج من مزالق التفكير المسدودة، التي شادها أرسطو بطريقة المنطق (الصوري) باعتماد (الاستنباط Deduction) من خلال تدشين (المنهج الاستقرائي Induction).
وبقي الفكر الإنساني معطلاً مشلولا ألفي عام، حتى ساد البشر مثل قالة السوء، حين يقول الناس، عن عقم أي محاولة للفهم والتفاهم بكلمة (الجدل البيزنطي)، أو عقم الفلسفة عموما بكلمة شعبية دارجة بين مجتمعاتنا ... فيقولون (لا تتفلسف؟!).
والفرق بين المنهجين كبير ، يقترب الأول فيه من الحقيقة بتطبيق القاعدة من فوق لتحت،
أما الاستقرائي فبالعكس، ويجمع الملاحظات من الواقع، ليشتق منها قانونا عاما، قابلاً للنمو.
وبالطريقة الأولى قاد الافتراض الخاطيء من بداية خاطئة إلى نتائج كارثية، وبالثانية أمكن وضع قوانين (الاحتمالات)، الذي صاغه الألماني (غاوس Gauss)، من خلال اعتماد منهج ديكارت في الهندسة التحليلية، ورسم المخططات البيانية.
والقرآن الكريم لفت النظر إلى (الواقع) بكل مافيه وحثنا على النظر فيه وفي الارض وفي أنفسنا وفي طعامنا
قال أنظروا إلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، والإبل كيف خلقت،
وأن صحة الكتاب المقدس ستظهر من خلال آيات الآفاق والأنفس.
وعندالفيلسوف الشاعر (محمد إقبال) ، تعتبر كلاً من (الطبيعة) و(التاريخ) مصادر أساسية للمعرفة.
وهو ما عاش عليه المسلمون وأهل الكتاب عموما، حين فكوا النصوص الدينية عن الواقع والطبيعة والتاريخ واليوم يرفض بعض المتشددون هذه الرؤية
وحين يتعطل العقل عن فهم مصادر الحقيقة، لا تفيده أية حقيقة،والكفر والإيمان هنا أصبحا مدارهما حول استخدام العقل لفهم مصادر المعرفة، أو تعطيل تلك الحواس.. فيمرون على الآيات وهم عنها معرضون..
صم بكم عمي فهم لا يعقلون..
وهكذا يتحرر العقل من المسلمات، ويرتكن إلى الواقع، فهو أصدق من كل نص كتب عنه مهما كان مصدره، لأنه النص الأساسي الذي لا يقبل التحريف والتغيير.
كذلك فإن (العبودية) ليست خطأ كرموسومياً؛ كما تصور أرسطو، بل قدراً يتشكل من خلال ثقافة إنسانية مريضة.
ولم تتحرر البشرية من أسر العبودية بالنصوص، بل بالتطور التاريخي.
فمتى نحرر عقولنا من أسرها
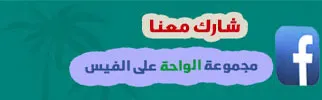
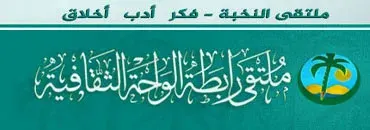



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس