و هنا يستيقظ العجب ..
القصة الشاعرة .. بين جدل الأرصفة و المؤسسات الثقافية
حين تعلم آدم الأسماء كلها ، أصبح مأموراً بالسعي والنظر والتفكر ليحقق إعمار الأرض الذي هو أحد أهم الأهداف السماوية لوجوده في هذا الكون. منذ ذلك الحين ظل آدم وبنوه في حركة دائمة لاكتشاف جديد على كل مستويات الحضارة ومعطياتها، ليبدو العالم على سطح الأرض كما نراه من اكتشاف واختراع وبنيان. وإذا كان إعمار الأرض يأتي كنتيجة لسلسلة ( السعي والنظر والتفكر )، فإن هذه السلسلة جميعها تكوّن الأركان الرئيسة لعقلية الأديب الذي يسلم بعد ذلك مفاتيح الإعمار إلى من يقوم بالتنفيذ. ثم يبدأ في عقد سلسلة جديدة ليظل القائد الحقيقي لمسيرة التطور الحضاري على مستوى الزمان والمكان.
وهكذا يبقى الأديب الحقيقي دوماً في سلسلة من التفكر ملازمة لنبض قلبه ولا تنقطع إلا بانقطاع ذلك النبض. وبينما ينتقل الأدب من مرحلة إلى أخرى ( وأخص الأدب العربي ) تظهر حركات التجديد التي تحدد ملامحه وأهدافه في كل مراحل تطوره. ومن هنا يصبح التجديد في ذاته سنة قديمة، لكنها دوماً تخلق كل ما هو غير مسبوق. وأبرز نماذج التجديد في الأدب العربي الحديث كان ابتكار جنس أدبي جديد.. ألا وهو القصة الشاعرة، والتي تعود ريادتها وتأصيل منهجها العلمي إلى الأديب محمد الشحات محمد مؤسس ورئيس جمعية دار النسر الأدبية لرعاية المواهب. ويعد العنصر الأبرز في جديدية / حداثة القصة الشاعرة، هو قدرتها على التفاعل الذهني بين الشعر والقصة ( كمثل المركب في المواد الكيميائية )، بحيث تأتي بعناصر جديدة للكتابة والتلقي، لتحقق هدف كلا الجنسين عند ذائقة القارئ، وفي الوقت نفسه تحقق أهدافاً أخرى أهمها ( خربشة ) العقل وتحفيز المتلقي للمشاركة الأصيلة في عملية الإبداع، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة في هذه العملية ، وهي اجتياز شركاء الإبداع لحاجز التفكر إلى أفق المشاركة في تنفيذ حركة الإعمار كانعكاس مادي لذلك التفكر.
وإذا كانت حركات التجديد الأدبي في مراحل سابقة تتعرض لدعاوى متباينة لإثبات نسب، فإن القصة الشاعرة تؤكد على تفرد العرب بهذا التجديد خاصة وإثبات نسب حركات التجديد السابقة إلى آبائها الشرعيين بشكل قانوني وعلمي واضح.
وقد اعتاد الأدب على تعسر ميلاد كل جديد، ويغلب الظن على أن السبب في ذلك التعسر هو البيئة الحاضنة لهذا الميلاد. هذه البيئة دوماً ما تتقلب على صخرتين من الثرثرة والصخب. ولا يخفى على أحد حالة التورم السرطاني التي أصابت هاتين الصخرتين لتصبحا طليعة الموكب الأدبي، فيصعب على عموم الناس – وقد أصابهم نفس الورم – تحديد أصحاب الموكب ورموزه، فتشيع الفوضى وتكثر الثرثرة ويعلو الصخب، ولا يستطيع المبدع الحقيقي إلا أن ينتبذ مكاناً قصياً يجد من خلاله صفاء الروح وهدوء الطبيعة وعطاءها.
وهذا أظنه ما حدث مع أديبنا محمد الشحات محمد، حين أدهش الموكب الأدبي بجنس أدبي جديد ينعم بصوت وصورة متفردين. ومع أن القصص الشاعرة تحفظ للعقل البشري حقه في الحياة، إلا أن غثاء القافلة لا يفتأ يغذي الورم المتفشي ليظهر سائداً مع كونه لا يتجاوز حدود اسمه.
نعم .. القصة الشاعرة تبث روحاً تجديدية محورية في تاريخ الأدب، وتشكل إبداعاً غير مسبوق من حيث البناء والأثر، وتشبع نهم النقاد والأدباء، بل الجمهور، وتجعلهم يسنون أقلامهم وأرواحهم لورود ذلك النبع المفعم بألق الطبيعة البكر، والتي نفتقدها الآن في كل مستويات الحياة.
ولأن الآداب غير العربية تحظى بحيز غير وفير من أشكال الموسيقى ووسائل الموسقة، كانت القصة الشاعرة دليلاً حقيقياً على السبق والتفرد العربيين في تجديد الخطاب الأدبي، مما يثير التساؤلات حول مراحل التجديد جميعها والجذور الأصيلة لهذا التجديد. ولو تتبعنا بعين المدقق الحركات الإبداعية المغايرة، لوجدنا أنها كلها تستقي من نبع التراث العربي الأصيل. وهنا تجدر الإشادة بدور المؤسسات الثقافية في إحياء تراثنا العربي الذي يثبت للعرب نسب كل الأبناء لآبائهم الحقيقيين بذوق رفيع وشرف محقق.
وبينما تأتي القصة الشاعرة بكل جديد ومدهش، تثير تناولاً مدهشاً أيضاً للموضوعات، يجعلها وجبة لا تفتقر لأي من العناصر الغذائية، بل تضيف إلى ذلك ذائقة جديدة يتوق إليها القارئ العربي والعالمي. وتنفرد القصة الشاعرة بأسلوب خاص في طرح الموضوعات يجعل القارئ ينظر من مختلف الزوايا وبمختلف العيون، وهذا ما يحقق للقارئ دوره البارز في عملية الإبداع.
ومما تم نشره من نصوص القصص الشاعرة، نجد أنها تستوعب الخوض في أي موضوع يطرأ على المجتمعات الحديثة. هذا الاستيعاب يأتي لكونها تقدّر مدى المفارقات والروابط والدلالات، مما يجعل النظرة عندها – أي القصة الشاعرة – أكثر شمولاً ومواجهة للحقيقة.
من خلال ذلك نستطيع مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية وغيرها وحتى نخترق حدود مثلث المحظورات بشكل علمي وإلهامي رائع. من هنا تناقش القصة الشاعرة كل ما يطرأ على العقل البشري المزدحم بأفكار وشبهات متباينة، ولكنها تؤكد في مجمل تناولاتها على فكرة أصيلة تجمع كل آفاق أفكارها في كون واحد يتلخص في معنى "الهوية" والذي – إن نظرنا مليّاً – نجده أصل كل تطور وجذر كل صراع ونقطة انطلاق كل حوار ولقاء.
من أهم ما ساعد على اكتمال هذا البنيان الجديد، تلك البيئة المحيطة من الزخم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونشوء نظرة جديدة للجمهور – بما فيه الأمي – تجعل منه ناقداً بطبيعته. وهذه النظرة نفسها نشأت في ظل عالم مفتوح الأفق مرفوع الستائر، مما جعله دائم التشكيك في كل ما يصطدم به عقله. وكاد هذا التشكيك أن يسلط لسان سيفه على كل مستحدث!
في ظل هذه البيئة المزدحمة بالفراغ من اللمسة الحانية، تولد القصة الشاعرة على يد أديب ظل عقوداً يسعى وينظر ويفكر، عابراً بذلك سماوات السلسلة الإبداعية، ومشاركاً بقلم لا يستكين في أشكال الأدب المختلفة قديمها وجديدها، ومغترفاً من معارف تراثية وحداثية ساهمت في تشكيل رأس حوى ألق العولمة وزقاقاتها في آن واحد. قلبي معه محمد الشحات محمد، كم عاش من العمر يشعل بجنون إبداعه نجوماً مطفأة، وكم ظل يسرج الضياء في نجوم أخرى لم تعرف طعم النور من قبل. وهنا أجد الحمل ثقيلاً، في زمن أتعبه جدل الأرصفة وأرهقه تذلل الحق على باب اللامبالاة، ودارت به رحايا البحث رمزاً عن رغيف خبز وملعقة زيت.
لكنه ليس بغريب أن يشقى الأديب لسعادة الأدب، وخاصة رواد التجديد الذين يشقون مرتين؛ مرة في رحلة الوصول إلى المبدعين أنفسهم، والمرة الأخرى في رحلة الوصول بالمبدعين إلى ذائقة القارئ الحقيقية. لكن أخيراً يبقى سؤال: كيف لا يرضى الناس بما هو قائم، ويسعون دائماً للتغيير، وعندما تظهر ملامح جديدة يكون رد الفعل اللاإرادي والأول هو عدم الرضا أيضاً؟!
نعود إلى بقعة الضوء المسلطة على معاداة كل رائد تجديد فكري، من شأنه أن ينتج كل جديد مادي يعشقه الجمهور من أول نظرة. فحينما يظهر اكتشاف أو اختراع مادي، تتلقفه الأفئدة، بينما الباعث الرئيسي لذلك الاختراع - وهو دوماً فكري وأدبي – يواجه بكثير من الجهل والنكران ... وهنا يستيقظ العجب.
أحمد السرساوي
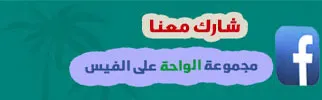
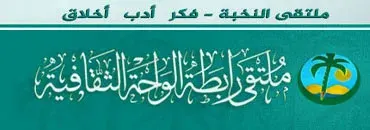



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس




