الأصواتيون وعِلم العَروض العربي.. عجيبٌ وأعـجب..!
بقلم/ أبو الطيب ياسر بن احمد القريني البلوي القُضَاعي، صاحبُ علم عَروض قضاعة. 30- 10- 2024
(1)
مقدمة:
أول ظهور لعلم أصوات اللغة الـمُحْدَث (Modern Phonetics)،كان على يد الباحث السويسري (فرديناند دي سوسير)، وذلك مع نشر كتابه الشهير في عام 1916م (دروس في علم اللغة العام Course in General Linguistics)، وكان ذلك بعد وفاته بثلاث سنوات. فهذا الكتاب ضمّ الملاحظات التي أبداها دي سوسير لطلابه في محاضراته التي ألقاها عليهم، وهي تتناول بعض الإشارات عن النظرية التي بلورها الباحثون فيما بعد، فعُرِفت باسم (نظرية دي سوسير)(1). وعلم الأصوات هو دراسة أصوات الكلام المنطوق، وهو ينقسم إلى فرعين رئيسيين: علم الأصوات اللغوية Phonetics، وعلم وظائف الأصوات (الفونولوجيا Phonology). فعلم الأصوات ينظر في الأصوات في حد ذاتها، فيدرس صفاتها من حيث إخراجها ومن حيث سماعها. أمّا علم وظائف الأصوات فهو يدرس الأصوات من حيث وظائفها في الاستعمال اللغوي. (2)
ويعتبر علم الأصوات فرع من علم اللغة العام الرئيس. كما ويعتبر علم الأصوات النُطقي، كفرع من فروع علم الأصوات المتعددة؛ من أقدم فروع علم الأصوات وأرسخها قدماً، وأكثرها حظاً من الانتشار في البيئات اللغوية كلها. ويرجع السر في ذلك على ما يقول كمال بشر، إلى وظيفة هذا الفرع، وإلى طبيعة الميدان المخصص له، الأمر الذي جعل الباحث العادي قادراً على الخوض فيه.(3)
(1) [نقلاً بتصرّف عن: دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، صلاح الدين صالح حسنين. ص 61].
(2) (دروس في علم أصوات العربية - جان كانتينو، ص 17)
(3) (علم الأصوات- كمال بشر، ص 41 – 42)
ولا بد لنا هنا قبل الاسترسال، أن نشير إلى المكوّنات الصوتية الخمسة الدّنيا في البحث الصوتي، مهما كان هناك اختلاف في طبيعة صوتها بين اللغات، ومهما كانت نظرة الباحث الصوتي لها. وهذه المكونات الصوتية الخمسة الدّنيا باستعمال مصطلحات العرب كالتالي:
1 - الحركات الثلاث: الفتحة، والضمة، والكسرة.
2 - حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء: نَار- نُور- دِين.
3 – حرفَـيّ اللين الواو والياء المسبوقتين بحركة الفتحة: دَين- حَوض.
4 - حرفَـيّ العلة الواو والياء المحركين: وَجد، يَجد.
5 - الحروف الصحيحة، وهي الهمزة، والباء، والتاء، والثاء ... الخ.
فهذه هي المكوّنات الصوتية الخمسة الدّنيا، سواء كانت هي نفسها التي يستعملها العرب بهذه المسميات، او كانت احد تنوعاتها التي لم يصنع العرب لها اسماءً ولا رموزاً. فاللغويون العرب يكتفون بتوصيف الحركات التي لا مسميات ولا رموز لها عندهم، أي أحد تنوعاتها الممكنة، وذلك بدلالة مسمّيات وأصوات الحركات الثلاث القياسية عندهم؛ فيقولون (مثلاً): (الحركة التي بين الفتحة والكسرة). ويقولون: (الفتحة المشوبة بشيء من الكسرة أو الضمة). وقل نفس الشي عن باقي المكونات الصوتية الدّنيا. ويطلق الاصواتيون على كل كائن صوتي من هذه الخمسة مسمّى "صوت" (Sound )
وقد جاء علم أصوات اللغة الـمُحْدَث بمفاهيم ومصطلحات متصادمة تماماً مع قال به اللغويون العرب. فهم لا يعترفون بمفهوم الحرف الصوتي الذي أنجب مفهوم المتحرك والساكن، فلا يستخدمون كلمة "حرف" إلّا للدلالة على الرمز الكتابي للصوت (4). ذلك انهم يرون أن الانسان قادر على نطق الحركات بمعزل عن الحروف، ونطق الحروف بمعزل عن الحركات، ويزعمون أن الاجهزة العلمية أثبتت ذلك..!(5). وهم يقولون أن الحركات نوعين، وليس كما ظن اللغويين العرب بأنها نوع واحد. فالحركات عندهم التي يسمونها "الصوائت"، تفريقاً لها عن "الصوامت" التي هي الحروف الصحيحة بمفهوم اللغويين العرب؛ تنقسم عندهم إلى صوائت قصيرة وصوائت طويلة، أي إلى حركات قصيرة وحركات طويلة.
فالحركات القصيرة عندهم هي الفتحة والضمة والكسرة وما على شاكلتها. أمّا الحركات الطويلة عندهم فهي بمفهوم العرب حروف المد الثلاثة مع الحركة المجانسة لصوت كلٍّ منها (الألف والواو والياء: نَار- نُور- دِين). فهم يقولون بأنهما من جنس واحد، فالحركة القصيرة قد تطول فتكون حركة طويلة؛ فالفرق بينهما على قولهم انما يكمن في الكم ومدّة النطق (Duration). بمعنى أن الحركة الطويلة حسب قولهم، تعادل ضعفيّ طول الحركة القصيرة الزمني في المتوسط. (6)
فالأصواتيون يصنّفون المكوّنات الصوتية الخمسة الدّنيا تصنيفاً آخر، ولهم مصطلحاتهم عنها غير مصطلحات العرب. فهي في علم أصوات اللغة المحدَث: الصوائت، والصوامت، وأشباه الصوامت وأشباه الصوائت؛ وما رُكّب عليها من مصطلحات أخرى كالألفون والفونيم. ودافع الاصواتيين في هذا التصنيف قد تأسس عندهم على مرتكزين متضادين؛ فقد ارتكز على فكرة مرور الهواء مروراً حرّاً أثناء النطق، من غير أن يكون هناك ثمة احتكاك أو إعاقة؛ وهذه هي الصوائت. أم أنه أثناء مروره قد واجه احتكاك أو إعاقة، وهذه هي الصوامت. (7)
(4) (الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، - في الهامش، ص 106).
(5) (مناهج البحث في اللغة، ص 139، تمام حسّان).
(6) [علم الأصوات- كمال بشر، ص 149، 207].
(7) (الأصوات اللغوية، ص 27، إبراهيم أنيس).
ولـمّا تخلّى الأصواتييون عن مفهوم الحرف الصوتي (Letter)كأداة صوتية يتم بها تقعيد وتفسير النواحي الصوتية والصرفية والاعرابية في اللغات؛ وكان لا بد من ايجاد كائن ومفهوم آخر يسدّ محله كي تستمر عجلة علمهم بالدوران؛ فقد زعموا بأن المقطع الصوتي (Syllable) على اختلاف أشكاله عندهم، هو المدرج الصوتي الحقيقي الذي ينتجه عضو النطق البشري [وليس الحرف الصوتي على ما توهّم اللغويون العرب]؛ وهو الذي تقوم عليه الناحية الصوتية في جميع اللغات بزعمهم. (8)
وعلى الدّقة، فالذي حلّ محلّ الحرف الصوتي عند الأصواتيين عدّة أفكار على السواء، هي: فكرة الصامت والصائت، وفكرة الفونيم ومعه فكرة الألفون، وفكرة المقطع (9). فبدلاً من قول (حرف الباء)، سيقولون فونيم الباء. وبدلاً من قول (حذف الحرف المحرك) أو (حذف الحرف الساكن) لسبب كذا، سيقولون أنّ التركيب المقطعي قد تغير هنا أو هناك، فطال ذاك المقطع أو قُصّر أو استُبدِل بآخر، لأن قوانين التركيب المقطعي للغة الفلانية لا تقبل بهذا أو بذاك.
( 8) (دراسة الصوت اللغوي- احمد مختار، ص 163).
(9) الفونيم والألفون ( The Phoneme and Allophone ) في علم أصوات اللغة المحدَث: الفونيم بشيء من الاختصار، هو كل كائن صوتي من وحدات البناء الصوتية الخمسة الدنيا، قادر على التفريق بين معاني الكلمات. وتنوعات الفونيم الممكنة تسمّى عندهم ألفونات (Allophones). وهذه الألفونات للفونيم الواحد قد تكون مشروطة ومقيّدة بسياقات معيّنة، وقد تكون غير مشروطة. لكن هذه التنوعات لا تؤدي إلى تغيير المعاني، وليس لهما من أثر يُذكر في البُنية أو في النظام الصوتي للغة، من نحو تفخيم الأصوات أو ترقيقها، كما في تفخيم اللام أو ترقيقها في كل من (الصلاة) و (الضلال)، فما زال حرف اللام مدركاً في هاتين الكلمتين. [راجع للاستزادة: (علم الأصوات-كمال بشر، ص 70، 71، 485، 490، 491].
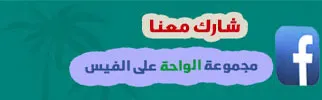
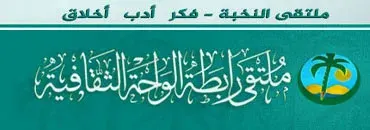



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس