«في معنى أُفّ»
الأُفّ من الجذر (أفف)، وهو الوسخ حول الظُّفُر، والتُّفُّ الذي في الظُّفُر.
وقيل الأُفّ هو وسخ الأذُن، والتُّفُّ وسخ الْأظْفار.
وتُقال هذه الكلمة عند استقذار الشيء، يُقال: أُفّاً لله وأُفَّةً له أَي قَذَرًا له.
ثم استعمل عند كل شيء يُضجر منه ويُتأذّى به، فهي كلمة تَضَجُّر.
قال تعالى في حقّ الوالدين: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا».
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: "وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما أف خاصة، وإنما المقصود النهي عن الأذى الذي أقلّه الأذى باللسان بأوْجز كلمة، وبأنها غير دالّة على أكثر من حصُول الضجر لقائلها دون شتم أو ذم، فيُفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى الخطاب بالأوْلى".
وقال تعالى: «أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ».
قال الطبري: "أُفٍّ لَكُمْ: قُبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرّ ولا ينفع، فتتركوا عبادته، وتعبدوا الله الذي فطر السماوات والأرض، والذي بيده النفع والضرّ".
وقال تعالى: «وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي».
قال الطبري: "أُفٍّ لَكُمَا قذراً لكما ونتناً".
وقال الطنطاوي في التفسير الوسيط: "والمقصود به هنا: إظهار الملل والتأفف والكراهية لما يقوله أبواه من نصح له".
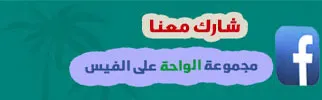
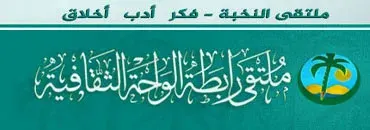



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


