لماذا كان إرسال الله للرسل قاطعاً لأيّ حُـجّة للناس على الله يوم القيامة..؟
بقلم/ أبو الطيب ياسر بن احمد القريني البلوي القُضَاعي، صاحبُ علم عَروض قضاعة.
إن المتأمل العميق لهذا الكون والإنسان، ولجميع الشرائع والكتب التي انزلها الله، لا بد أن يدرك بأنه ما من منفَذ قد يحتج به الإنسان على خالقه يوم القيامة، ليدفع عن نفسه العذاب المستحَق؛ إلّا وقد أقفله الله رب العالمين.
فمن لم تبلغه الرسالة بشكل بيّن واضح، فلا عذاب عليه حتى لو كفر..! قال تعالى: ﴿وما كنّا معذِّبينَ حتّى نَبعثَ رسولاً (15)﴾ (س. الإسراء).
ورغم أن إدراك وجود الله هو من أسهل العمليات العقلية، مهما كان مستوى الإنسان التعليمي والثقافي، خاصة مع وجود دافع الفطرة عند كل إنسان؛ وأن الله أشهد جميع البشر على أنفسهم في عالم الذّر بأنه خالقهم وربهم، فشهدوا بذلك وأقرّوا، وغرس الله هذا الأمر في خِلقتهم؛ إلّا انه سبحانه لم يجعل هذا الميثاق بينه وبينهم هو الحجة القاطعة عليهم، بل علّقه بمبعث الرّسل. قال تعالى: {وإِذ أخذَ ربّكَ مِن بنِي آدمَ مِن ظهُورِهِم ذُرِّيّتهُم وأشهدهُم على أنفُسِهِم ألستُ بِربِّكم..؟ قالوا بلى شهِدنا أن تقولوا يومَ القِيامةِ إِنّا كنّا عن هذا غافِلِين (172) أو تقولوا إِنّما أشركَ آباؤنا مِن قبلُ وكنّا ذرِّيّةً مِن بعدِهِم أفتُهلِكنا بِما فعلَ المبطِلونَ (173) وكذلِك نفصِّلُ الآياتِ ولعلّهم يرجِعون (174)} (س. الأعراف).(1)
(1) راجع مقالتنا في رابطة الواحة التي عنوانها (الفطرة والميثاق، محاولة لتفكيك اللغز)
والسؤال هنا: لماذا كان إرسال الله للرسل قاطعاً لأيّ حُـجّة للناس على الله يوم القيامة وليس ذاك الميثاق، وكيف يكون ذلك..؟ والجواب على ذلك من وجهين، الأول: هو وجه عَقليّ، طالما أن العقل هو مناط التكليف لكل إنسان. فإدراك وجود خالق لهذا الكون ليس من شأن النصوص المنزلة على الرُسل؛ فهذه النصوص إنما ستؤكد للإنسان صدق تفكير العقل بهذا الأمر فقط. والعقل في حكمه على الوقائع ليس بمستوى واحد، فمن الوقائع ما يكون حُكم العقل على وجودها حُكماً قطعياً مئة بالمئة، وذلك كالحكم على المحسوسات بإحدى أدوات الحس المادية لدى الإنسان، وهي السمع والنظر والشم والتذوق واللمس.
ومن الوقائع ما يكون حُكم العقل عليها حكما ظنيّاً وليس قاطعاً، مهما ارتفع مستوى الظن، وهي التي يتفاوت الناس ويختلفون في الحكم عليها. ومن ذلك الوقائع المحسوسة بأثرها وليس بذاتها، وذلك كإدراك وجود طائرة في الأجواء من صوتها دون رؤيتها؛ أو الحكم على حصول زلزال بسبب اهتزاز الجدران والسقف، فاحتمالية أن ما سمعته من صوت ليس بصوت طائرة حقيقة، وان سبب اهتزاز الجدران ليس بهزة أرضية؛ هو احتمال وارد لا يجوز إغفاله، مهما كان ضئيلاً.
ومن الأمور الأخرى التي يكون فيها حُكم العقل على الوقائع حكماً ظنيّاً، هو الحكم على ماهية الأشياء، فالحكم على وجود الشمس فرع، والحكم على ماهيتها هو حُكم عقليّ آخر. والحكم على وجود العقل نفسه أمر، والحكم على ماهيته هو حُكم عقليّ آخر. فماهيته الواقع بعد التأكد من وجوده طبعاً؛ هو جواب لتساؤل: لماذا هذا الواقع على هذا الوجه وليس ذاك، ومما يتألف على الحقيقة وليس على التوهم، وما الرابط بين الأشياء التي يتألف منها؛ وما هو الهدف أو الفائدة المرجوة من كل ذلك. ومما يجدر بنا ذكره هنا، أن الحكم على ماهية الواقع المعين ظنيّ بطبعه، أي لن تفارقه الناحية الظنية مهما علت درجة الظن. (2)
(2) راجع كتابنا (مختصر خريطة العقل) الموجود على مكتبة نور في الانترنت.
وإدراك وجود الله من أثره في مخلوقاته، هو مثال عن الواقع المحسوس بأثره، والذي فيه جانب ظنيّ مهما علت درجة الظن كما قلنا (والله المثل الأعلى). قال تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ﴿وإذ قُلتم يا موسى لن نؤمنَ لكَ حتّى نَرى الله جَهرة فأخذَتكُمُ الصّاعقَةُ وأنتم تنظُرون (55)﴾ (س. البقرة). والذي سيرفع درجة إدراك وجود الله للدرجة القطعية (100%) هو مبعث الرسل..؟ وذلك للتلازم المصيري بين إثبات وجود الله وبين إثبات أن الرسول مرسل من الله حقاً. قال تعالى: ﴿رُسُلاً مبشّرينَ ومنذِرينَ لئلّا يكون للنّاسِ على الله حُجة بعد الرّسُل وكانَ الله عزيزاً حكيماً (165)﴾ (س. النساء). وقال تعالى: ﴿وللّذينَ كفروا بربّهم عذابُ جَهنّمَ وبئسَ المصيرُ (6) إذا أُلقوا فيها سَمعوا لها شَهيقاً وهي تفورُ (7) تكادُ تميّـزُ من الغَيظِ كلّما أُلقيَ فيها فوجٌ سَألهم خزنَتُها ألَم يَأتكُم نذيرٌ (8) قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّبنا وقُلنا ما نزّلَ الله من شيءٍ إن أنتم إلّا في ضلالٍ كبير (9)﴾ (س. الملك).
فمع أنّ الظن بوجود خالق لهذا الكون والإنسان هو ذو قيمة ظنية مرتفعة، وذلك لوضوح هذا الأمر لكل إنسان خال من الهوى. فهذا الظن في ظل غياب رسالة الرسول، وعند الباحث الجاد؛ لن يقل بحال عن درجة الثاقب المعتبرة في الحياة (65 – 69 %)، وقد يصل لدرجة العازم القوية (85 – 89 %). لكن لأنه لم ولن يصل بعد لدرجة اليقين، ستظل بعض النفوس حائرة بشأن هذا الأمر، لكون أنّ تبعاته على كيان الإنسان وحياته خطيرة جداً. وهذا الواقع الذي قلناه محسوس مشاهد في قصص المتحولين للإسلام من غير النصرانية، فيكثر في قصص المخلصين منهم بعد قراءتهم للقران مترجماً بلغتهم، سماع قولهم (هذا ما كنت أفكر فيه من قبل..!).
فإثبات الرسول للناس انه رسول من الله عن طريق المعجزات الخارقة للعادة، والتي لا يقدر عليها السحرة، ومن ثم إبلاغ الرسول الرسالة عن الله للناس بوضوح وبراهين، يجبر النسبة المتبقية من الظن بوجوده إلى الدرجة القطعية. ومن هنا فإن مبعث الرسل فيه قطعٌ لأيّ حجة قد يتذرع بها الإنسان يوم القيامة، ليدفع عن نفسه العذاب المستحَق. وهذه الظنية في إدراك وجود خالق للكون والإنسان، هو المتوافق مع كون العقل هو مناط التكليف في جميع الشرائع، فإدراك وجود خالق لهذا الكون ليس من شأن النصوص المنزلة على الرُسل كما قلنا؛ فهذه النصوص إنما ستؤكد للإنسان صدق تفكير العقل بهذا الأمر فقط؛ وستضيف إليها أموراً أخرى ما كان العقل سيدركها لوحده، كالبعث والجنة والنار والملائكة وباقي صفات الله التي لا يمكن للعقل وحده التوصل لها.
فمن مستلزمات إدراك وجود خالق لهذا الكون، أنه يجب أن يتمتع بصفات تؤهله لأنْ يكون هو الإله الخالق للكون والإنسان بحق. فليس يكفي إدراك وجوده سبحانه فقط، بل يجب إدراك أنه أزلي الوجود، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا إله إلّا هو، وأنه مطلق القدرة وعليم، فهذه الصفات المذكورة وإن كان يمكن للعقل وحده التوصل لها، فإن لله صفات لا يمكن للعقل أدركها مهما تفكر بها يعيداً عن رسالة الرسول، ومن ذلك صفة الرحمة والمغفرة وما على شاكلتها.
أمّا الوجه الثاني لكون أنّ مبعث الرسل فيه قطع لحجج الإنسان يوم القيامة، ليدفع عن نفسه العذاب المستحَق؛ هو قضية تتعلق بالحكمة من خلق الإنسان وهذه الدنيا، وعلاقتهما بالآخرة. فلو اقتصر امتحان الدنيا على إدراك وجود الله فقط، ومن ثم الإيمان به، كما هو حاصل في النصرانية المحرّفة؛ لـمّا اخترع الرهبان الأولون كذباً على الله فكرة المخلّص يسوع؛ لكان النجاح في امتحان الدنيا ميسوراً لكل إنسان. ومن هنا فإنه عدا عن الإنسان عاجز عن أن يضع لنفسه منهجاً متكاملاً يشتمل على كل أحواله ومجتمعه، فالإنسان بحاجة لشرع من خالقه يبيّـن له ما سيعجز عقله عن إدراكه مهما سما في تجاربه، ومن أسئلة عَقديّة ومن أحكام تنظم شؤونه في الحياة، على اعتبار أنّ خالق الإنسان أعرَف بما يُصلح معاش الإنسان وعلاقته ببني جنسه، وأنّ العقل كثير الخطأ في ذلك على ما هو مشاهد.
أقول: فعدا عن ذلك، فإن الله يمتحن عباده بهذه المنهج ليعلم من يطيعه بالغيب ممن يعصيه، إقامة للحجة على الإنسان من نفسه وليس جهلاً من الله بحاله والعياذ بالله. قال تعالى (ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلّام للعبيد) (سورة آل عمران 3). وقال تعالى: ﴿من اهتدى فإنّما يَهتدي لنفسه ومن ضَلّ فإنّما يَضِلّ عليها؛ ولا تزِرُ وازِرةٌ وِزر أخرى؛ وما كنّا معذِّبينَ حتّى نَبعثَ رسولاً (15)﴾ (س. الإسراء). وقال تعالى (ليعلم الله من يخافه بالغيب) (سورة المائدة 5). وقال تعالى (إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير) (سورة الملك 7). وقال تعالى: ﴿إنّما تُنذِرُ من اتّبَعَ الذكر وخشيَ الرّحمنَ بالغَيبِ فبَشّره بمغفرةٍ وأجرٍ كريم (11)﴾ (سورة يس).
انتهت هذه المقالة.
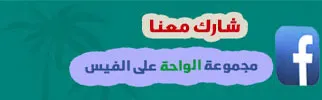
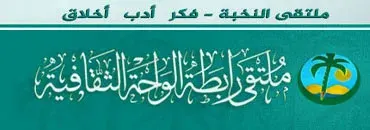



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

