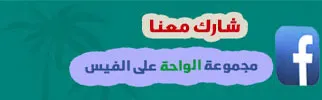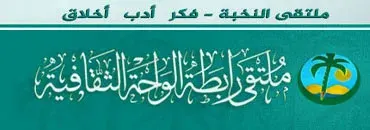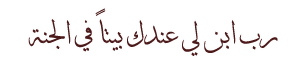إِنَاؤُكَ مِنْ قَمْحِ الفَجِيعَةِ قَدْ أَجْفَى وَمَاؤُكَ مِنْ قرْحِ الوَجِيعَةِ قَدْ جَفَّا
وَوَجْدُكَ مِنْ رِيحِ الذَّرِيعَةِ جَمْرَةٌ وَغَيثُكَ مِنْ رُوحِ الشَّرِيعَةِ قَدْ أَطْفَا
أَلا أَيُّهَا السَّارِي عَلَى دَرْبِ هِمَّةٍ تَعزُّ عَلَى الشَّكْوَى وَتَفْخَرُ بِالأَكْفَا
هُوَ العَهْدُ فَانْزَعْ نَزْغَةَ السُّخْطِ بِالرِّضَا وَرُدَّ اللَيَالِي بِالمَحَبَّةِ وَالزُّلْفَى
فَحِلْيَةُ مَنْ يَسْمُو عَلَى الغَيظِ حِلْمُهُ وَلَيسَ شَدِيدًا مَنْ يُنَازِعُهَا العُنْفَا
وَكُلُّ إِنَاءٍ مِنْ هَوَى النَّفْسِ نَاضِحٌ فُصُبَّ مِن الإِبْرِيقِ أَعْذَبَهُ رَشْفَا
عَجِبتُ مِن الأَيَّامِ مَا انْفَكَّ دَأْبُهَا يَدُورُ عَلَى ذَاتِ الوَتِيرَةِ لا يَغْفَى
أَفِي اليَومِ مَا فِي الأَمْسِ وَالأَمْسِ فِي غَدٍ وَمَا عَرِفَتْ إِلا الغَيَاهِبَ وَالعَصْفَا
تَدُورُ بِذَاتِ الكَأْسِ مَا بَينَ نَاقِمٍ وَبَينَ ظُنُونٍ مَا شَقَقْنَ لَنَا جَوْفَا
كَأَنَّ العُلا لَمَّا تَسَاقَى مُدَامَتِي سَقَى أَلْفَ نَفْسٍ مِنْ تَمَيُّزِهَا زَعْفَا
وَقَالُوا هَجَاكَ القَومُ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ فَقُلْتُ: سَلامًا لا أَمسُّ لَهُمْ طَرْفَا
هُمُ الصَحْبُ وَالأَحْبَابُ لا مِثْلَ صَاحِبٍ يُعَبِّقُ أَنْفَ العَيشِ مِنْ نُصْحِهِ عَرْفَا
وَكَمْ طَائِرٍ أَقْلَى مِنَ النَّقْرِ إِلْفَهُ فَذَابَ حَنِينًا لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ إِلْفَا
فَإِنْ مَدَّتِ الكَفَّينِ مِنْهُمْ جِنَايَةٌ فَمَا الفَضْلُ إِلا أَنْ أَمُدَّ لَهُمْ كَفَّا
وَإِنْ قَدَحُوا بِالصَّدِّ فِي القَدْرِ مَرَّةً فَقَدْ مَدَحُوا بِالوُدِّ فِي قَدْرِنَا أَلْفَا
وَلِي قَلْبُ عِرْفَانٍ عَصَرْتُ شَغَافَهُ سُلافَ وَفَاءٍ مِنْ عَلائِقِهِ صِرْفَا
تُرَاودُهُ الأَحْدَاثُ مِنْ كُلِّ مِرْيَةٍ فَمَا مَالَ عَنْ نَهْجِ الوَقَارِ وَلا خَفَّا
إِذَا غَرِمُوا أَعْفَى وَإِنْ ظَلَمُوا عَفَا وَإِنْ سَقِمُوا عَافَى وَإِنْ شَتَمُوا عَفَّا
وَإِنْ نَكَثُوا وَافَى وَإِنْ غَدَرُوا وَفَى وَإنْ طَلَبُوا أَوْفَى وَإِنْ بَخَسُوا وَفَّى
مُحِيطٌ أَنَا لِلشِّعْرِ قَاعِي مُمَرَّدٌ وَمَائِيَ مِنْ عِطْرِ الزَنابِقِ أَو أَصْفَى
وَصَيدُ مَجَالِي جَاوَزَ المَدَّ وَالمَدَى وَبِنْتُ خَيَالِي لا يُحَاطُ بِهَا وَصْفَا
وَمَا كُنْتُ أَرْضَى الحَرْفَ إِلا نَسِيجُهُ حَرِيرٌ بِأَحْدَاقِ الجَوَاهِرِ قَدْ حُفَّا
أُغَنِّي ؛ وَمَا فِي النَّايِ إِلا حُشَاشَتِي تَرَانِيمَ قَلْبٍ لا أَكِلُّ بِهِ عَزْفَا
بِشِعْرٍ سَرَى فِي الصَّدْرِ كَالبَدْرِ فِي الدُّجَى يُلامِسُ فِي الوجْدَانِ بِالنُّورِ مَا اسْتَخْفَى
وَفِكْرٍ جَرَى فِي الدَّهْرِ كَالنَّهْرِ فِي الحِجَا يُطِيبُ لأَهْلِ الرَّأْيِ مِنْ نَبْعِهِ الغَرْفَا
فَكَيفَ يُنِيبُ العَبْدَ مَنْ كَانَ سَيِّدًا وَكَيفَ يَسُومُ النِّصْفَ مَنْ يَمْلكُ الضِّعْفَا
وَلَو كُنْتُ مَخْبُولا لَمَا كُنْتُ جِئْتُهَا فَكَيفَ وَقَدْ كُنْتُ الحَكِيمَ الذِي يُقْفَى
وَلَكِنْ دَهَانِي بَرْزَخُ الحِفْظِ للِأُلَى وَإِبْدَاعِ نَظْمِي بِنَزْرِ مَرْجٍ وَقَدْ أَغْفَى
أَمَا اخْتَلَطَتْ بِيضُ اللآلِي وَسُودُهَا؟ فَكَيفَ جَرَتْ فِي السِّلْكِ وَانْتَظَمَتْ صَفًّا؟
إِذَا دَارَ قَصْدُ المَرْءِ دَارَى رَشَادهُ وَسَاقَ دَلِيلَ العَقْلِ فِي الحُكْمِ وَاسْتَكْفَى
وَمَا كُلُّ مَا يَبْدُو مِن الأَمْرِ ظَاهِرًا كَفِيلٌ بَأَنْ يُجْلَى الصَّوَابُ بِهِ كَشْفَا
فَمَنْ كَانَ عَفَّ القَصْدِ صَدَّقَ وَاتَّقَى وَأَدْرَكَ أَنَّ السَّهْوَ لا يُوجِبُ القَذْفَا
وَمَنْ كَانَ ذَا حِقْدٍ عَلَى الشَّأْنِ وَالسَّنَا تَحَرَّى الثُّرَيَّا أَنْ يُسَاوِمَهَا الخَسْفَا
يَظُنُّ بِرَجْمِ النَّجْمِ بِالوَجْمِ شُهْرَةً وَيَحْسَبُ أَنَّ الشَّأْفَ فِي صَدْرِهِ يَشْفَى
أَرَانِي كَأَنَّ اللهَ بِالخَيرِ خَصَّنِي فَقَيَّضَ لِي الحُسَّادَ تَخْدِمُنِي عَكْفَا
كَسَونِي كِرَامَ القَومِ تَسْخُو بِفَضْلِهَا وَعَرَّوا لَئِيمَ النَّفْسِ يُبْدِي الذِي أَخْفَى
وَإِنِّي أَمُدُّ الكَفَّ للهِ سَاجِدًا بِشُكْرٍ وَقَدْ أَهْدَى الكِرَامَ لَنَا صَفَّا
بِحُرٍّ سَلِيلِ المَجْدِ مِنْ آلِ غَامِدٍ وَلَو قَامَ فَرْدًا لِلجُنَاةِ فَقَدْ كَفَّى
وَهَذَا نَدَى مَحْمُودَ قَدْ زَادَنِي أَخًا وَهَذَا جَلالُ الصَّقْرُ قَدْ فنَّدَ السُّخْفا
وَفَاحَ شَذَا الإِنْسَانِ مِنْ أُمِّ ثَائِرٍ تَلِيدًا وَمِنْ سُقْيَا وَفَاءَ أَرَى الوَطْفَا
وَمَازِنُ هَذَا البَرُّ ذُو الرَّأْيِ عَاضِدًا وَسَالِمُ صِنْوُ النَّفْسِ قَدْ عَطَّرَ الأَنْفَا
وَفَضْلُ الخُدَيدِي سَابِقٌ غَيرُ لاحِقٍ وَزِيدَانُ ذُو الإِحْسَانِ بِالوُدِّ قَدْ أَلْفَى
وَأَسْمَعُ مِنْ زِيبَارِ لِلفِكْرِ صَوْلَةً فَيَحْلُو لِعَقْلِ الحُرِّ مِنْ كَرْمِهِ قَطْفَا
ونَادِيَةُ الإِصْرَارِ هَمًّا وَهِمَّةً وَجُهْدُ رَنِيمِ الصِّدْقِ لَمْ يَعْرِفِ الخلْفَا
وَزَاهِيَةٌ بِالحَقِّ وَافَتْ فَأَنْصَفَتْ وَوَافَقَ فِيهَا المَنْطِقُ الدِّينَ وَالعُرْفَا
وَزَهْرَاءُ وَالشَّحَّاتُ وَالخَالِدِي مُنَى وَمَرْحَةُ وَالغَنَّامُ قَدْ أَنْصَفُوا الحَرْفَا
جِهَادُ وَعَبْدُ اللهِ وَالشَّهْمُ عَايِدٌ وَيَحْيَى وَنَجْوَى وَالحُسَينِيُّ مَنْ أَضْفَى
وَرِيمُ ، ثُرَيَّا وَالعَطِيَّةُ والذِي يُحَدِّثُ أَهْلَ الحَقِّ حُسْنًا وَمَنْ قَفَّى
سَتَعْلُو شُمُوسُ النُّورِ فِي وَاحَةِ العُلا وَيَسْرِي دُعَاةُ الخَيرِ فِي ظِلِّهَا حِلْفَا
وَمَنْ كَانَ رَبُّ النَّاسِ فِيهِمْ حَسِيبَهُ فَلَنْ يُزْدَرَى فِي القَدْرِ يَومًا وَلَنْ يُنْفَى