فإن قيل : كيف تُنوَّن الكلمةُ في حالة الجرّ ، وهي غيرُ مُنصرِفةٍ ؟
قلنا : هو تنوينُ عِوَضٍ ، لا تنوينُ صَرْفٍ . ثم إن الكلمة تُنوَّنُ في حالة الرفع أيضا ؛ فمَن أنكر تنوينَها في الجرّ ، بحُجة الاستناد إلى ما يحسبه (منطقا نحويا !) ، لَزِمَهُ إنكارُ تنوينِها في الرفع أيضا .
-8-
فإن قيل : هل من نصوص للعلماء في ذلك ؟
قلنا : يكفينا قولُ ابن مالك في ألفيّته :
وكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ (مَفاعِلا) *** أوِ (المَفاعِيلَ) بِمَنْعٍ كافِلا
وذا اعْتِلالٍ مِنهُ كـ(الجَوَاري) *** رَفْعًا وجَرًّا أَجْرِهِ كـ(سَارِ)
-9-
فإن قيل : هذا قولٌ لا شواهد تُؤيّده .
قلنا : هذا تسرُّعٌ في الحُكم ، وقول بلا علم .
* فمن شواهد القرآن الكريم :
- قوله تعالى : (قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا] (مريم : 10] .
- وقوله تعالى : (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا] (الحاقة : 7] .
- وقولُه تعالى : (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ] (الفجر : 1-2] .
* ومن شواهد حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) : (لَيْسَ فيما دُونَ خمسةِ أَوْسُقٍ من التَّمْرِ صدقةٌ ، وليْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقةٌ ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ) [متفق عليه] .
* ومن شواهد أشعار العرب :
- قولُ لُمَيْس بن سعد البارقي (صاحب حلف الفضول) :
وناديتُ قومي بارِقًا لتُجِيبَني *** وكمْ دُون قوْمي مِنْ فَيَافٍ ومِن سُهْبِِ
-وقولُ أبي حيّة :
وأيْدي المَهاري في فَيَافٍ عريضةٍ *** هوابِطَ من أخرى تغلَّى وترتمي
- وقولُ امرئ القيس :
لَيَالٍ بذاتِ الطَّلْحِ عند مُحَجَّرٍ *** أحَبُّ إلينا مِنْ لَيَالٍ على أُقُرْ
- وقولُ الفرزدق :
وأقرَبُ الرّيفِ منهمْ سَيرُ مُنجَذِبٍ *** بالقَوْمِ سَبْعَ لَيَالٍ رِيفُهُمْ هَجَرُ
- وقول كعب بن زهير :
وبعْدَ لَيَالٍ قد خَلَوْنَ وأشهُرٍ *** على إثْرِ حَوْلٍ قد تجرَّمَ كاملِ
-وقول نَهْشَل بن حَرِّيّ :
بِرَجْمِ قَوَافٍ تُخرِجُ الخبْءَ في الصفا *** وتُنْزِلُ بَيْضاتِ الأَنُوقِ من الوَكْرِ
-وقول عنترة :
فدَعُوني مِن شُرْبِ كأسِ مُدامٍ *** مِن جَوَارٍ لهُنّ ظَرْفٌ وطِيبُ
-وقول النابغة الذبياني :
عهدْتُ بها سُعْدى ، وسُعْدى غريرةٌ *** عَرُوبٌ تَهادَى في جَوَارٍ خَرَائِدِ
-وقول بشّار بن بُرْد :
ومَلْعَبٍ لِجَوَارٍ ينتقدْن به *** وكُلُّ مُنتزَهٍ لِلَّهْوِ مُنتقَدُ
-وقول أوس بن حَجَر :
ومُعصَّبين على نَوَاجٍ سُدْتَهُم *** مثل القِسِِيِّ ضَوامرٍ بِرِحالِ
- وقول الأعشى (يذكُر ناقته) :
تَقْطَعُ الأمْعَزَ المُكوْكِبَ وَخْدًا *** بنَوَاجٍ سريعةِ الإيغالِ
-10-
فإن قيل : قد وقعت الياء مفتوحة في بيت الهُذَلي :
أبِيتُ على مَعارِيَ واضحاتٍ *** بهنّ مُلَوَّبٌ كدَمِ العِباطِ
وفي بيت الفرزدق :
فلو كان عبدُ اللهِ مَوْلًى هَجوْتُهُ *** ولكنّ عبدَ اللهِ مَوْلَى مَوالِيَا
وفي بيت الكُمَيْت :
خَرِيعُ دَوَادِيَ في مَلْعَبٍ *** تَأزَّرُ طَوْرًا وتُلقي الإزارا
قلنا : هذه أبياتٌ أتى بها الخليل بن أحمد ، فيما نقله عنه سيبويه في الكتاب [3/313-316] ، في معرض حديثه عن جواز تحريك الياء للضرورة الشعرية .
وبالطبع ، يستثنى بيتُ الهذلي . فقد كان بإمكانه القول : (مَعارٍ) ، دُون أن ينكسر الوزن ؛ ولكنه آثر إتمام الوزن ، وتجنُّب الزحاف .
ويُحتمل أن يكون فتحُ الياء لغة لبعض العرب .
ولكن اللغة الفصيحة التي جاء بها القرآن الكريم هي المذكورة آنفا .
وقد أورد الخليل بيتين آخرين ، حُرِّكت فيها الياء بالكسر ؛ وهذه ضرورة واضحة جليّة .
ويتعلق الأمر بقول ابن قيس الرُّقَيّات :
لا بارَكَ اللهُ في الغوانِيِ هَلْ *** يُصْبِحْنَ إلاّ لهُنَّ مُطَّلَبُ
وقول جرير :
فيَوْمًا يُوافِيني الهوَى غيْرَ ماضِيٍ ***ويومًا تَرى منهنَّ غُولاً تَغَوّّلُ
-11-
وبقي الحديث عما ذكره بعض المشاركين في النقاش المشار إليه في بداية الموضوع ، من أن يونس خالف الخليل في المسألة ، ورأى جرّ الأسماء المذكورة بالفتحة الظاهرة على الياء .
فأقول : هذا مجرد وهم ، سرعان ما يتبيّن أمرُه عند تأمُّل كلام سيبويه من أوله إلى آخره .
لنتأمل هذه المقتطفات من كلامه : (وسألتُ الخليل عن رجل يسمى بـ (قاض) ...) ، (وسألتُ الخليل عن رجل يسمى بِـ(جَوَارٍ) ...) ، (وسألته عن (قاضٍ) اسم امرأة) (وسألته عن رجل يسمَّى (أعْمَى) ، فقلت : كيف تصنع به إذا حقّرته ؟ فقال : أقول : (أُعَيْمٍ) ...) ، (وسألته عن رجل يسمَّى (يَرْمِي) أو (أرمي) ...) .
ثم بعد هذا كله يقول : (وأمّا يونس ، فكان ينظر إلى كلّ شيء من هذا – إذا كان معرفة– كيف حالُ نظيره من غير المعتلّ معرفةً . فإذا كان لا ينصرف [يقصد : لا يُنَوَّن] ، لم ينصرف . يقول : (هذا جَوَارِي قد جاء) و(مررتُ بِجَوِارِيَ قبْلُ ...) .
فالكلام هنا كله – كما يبدو لكل ذي بصيرة – عن الأسماء المنقوصة بصفة عامّة ، إذا سُمِّيَ بها ؛ أي : عن أسماء العَلَم . وكلمة (مَعْرِفة) في كلام سيبويه هنا تعني اسم عَلَم .
كيف ؟
قد يكون استعمال أعلام منقوصة كهذه محدود الانتشار في عصر يونس والخليل ؛ ولكنه في عصرنا الحاضر واسع الانتشار . فنحن نسمي (شادي) و(فادي) و(رامي) و(مَغازي) و(أماني) و(معالي) ونحو ذلك . فكيف نُعامل هذه الأسماء ؟
لو كان (شادي)اسما غير علَم ، لوجب القول : (جاءَ شادٍ جميلُ الصوتِ) (سمعتُ شادِيًا جميلَ الصوتِ (مررتُ بِشادٍ جميلِ الصوتِ) .
لكن ، ماذا لو كان (شادي) وما شابهه علَما ؟
أما في حالة النصب ، فنقول : (رأيتُ شادِيًا) إذا كان مذكرا ، و(رأيتُ شادِيَ) إذا افترضنا أنه مؤنث ، و(رأيتُ أمَانِيَ) مذكّرا كان أم مؤنثا .
وأما في حالتي الرفع والجر ، فهنا موضع الخلاف بين الخليل ويونس :
* فالخليل يرى بقاء الاسم على ما كان عليه قبل العلميّة : (شادٍ وأَمانٍ مِنْ أكثر التلاميذ اجتهادا) (مررتُ بِشادٍوأَمانٍ) ، مذكرين كانا أم مؤنثين .
* ويونس يرى الإتيان بالياء ساكنة في الرفع ، وساكنة أو مفتوحة في الجرّ (بحسب انصراف الاسم وعدمه) : (شادي وأَماني مِنْ أكثر التلاميذ اجتهادا) للمذكّر والمؤنث ، (مررتُ بِشادي) للمذكّر ، (مررتُ بِشادِيَ) للمؤنث ، (مررتُ بأَمانِيَ) ، للمذكّر والمؤنث .
فالخلاف بين الخليل ويونس منحصر في أسماء العَلَم ، وبالتحديد : في حالة رفعها أو جرّها .
فقول يونس : (هذا جَوَارِي قد جاء) و(مررتُ بِجَوِارِيَ قبْلُ) لا يقصد به جمع (جارية) ، وإنما يقصد به رجُلا اسمه (جَوَارِي) ، بدليل (هذا) و(جاء) .
وقد صرّح علماء النحو بما ذكرتُه ، من أن الخلاف بين الخليل ويونس منحصر في الأعلام المرفوعة والمجرورة .
يقول السيوطي في (هَمْع الهوامع) [1/117-118] :
(ولا يجوز في هذا النوع ظهور الفتحة على الياء في حالة الجر ، كما لا يجوز إظهار الكسرة التي الفتحةُ نائبةٌ عنها .
وقيل : يجوز كما يجوز إظهارها حالة النصب ، لخفتها . وعليه قول الشاعر :
ولكنّ عبْدَ اللَّهِ مَولْى مَوَاليا
وقيل : يجوز في العَلَمِ دُونَ غيْرِه . وعليه يونس . واستدلّ بقوله :
قد عَجبتْ مِنّي ومن يُعَيْلِيَا
وأُجيبَ بأنه وما قبله ضرورةٌ ) .
ويقول ابن جني في خصائصه (باب تركيب المذاهب) :
(وكان أبو عثمان أيضا يرى رأي سيبويه ، في صرف نحو (جَوَارٍٍ) عَلَمًا وإجرائه بعد العلميّة على ما كان عليه قبلها ، فيقول في رجل أو امرأة اسمها (جَوَارٍ) أو (غَوَاشٍ) بالصرف في الرفع والجر على حاله قبل نقله ، ويونس لا يَصْرِفُ ذلك ونَحْوَهُ عَلَمًا ، ويُجْريه مجرى الصحيح في ترك الصرف) .
ثم إن الخليل يقول ، في مناقشته لرأي يونس : ( ... ولكانوا خُلَقاءَ أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجرّ ، فيقولوا : (مررتُبِجَوَارِيَ قبلُ) ...) .
فالخليل يقول : لو صحّ كلام يونس ، لكان أحرى بالعرب أن يفتحوا الياء في (بِجَوارِيَ) في حالة كونها نكرة [يقصد : غير علم] ، أي : في حالة دلالتها على جمع (جارية) .
وهذا يعني أن يونس نفسه يقول : (مررتُ بِجَوَارٍ قبلُ) ، في حالة دلالتها على جمع (جارية) ؛ إذ لا يُعقل أن يحتجَّ الخليلُ عليه بشيءٍ ، وهو يعلم أنه غيرُ مقتنع به أصلاً !
-12-
وعليه ، يكون جواب السؤال المطروح في أول الموضوع – على الأفصح - كالآتي :
* هذه قَوَافٍ جميلةٌ .
* قرأتُ قَوَافِيَ جميلةً .
* يا لها مِنْ قَوَافٍ جميلةٍ !
***
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه .
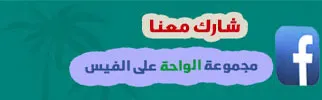
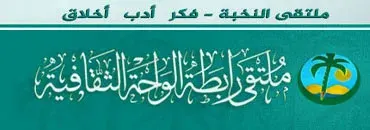



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس



