المخاتلة الإبداعية
المتوالية العجائبية في الكون والوجود
حوارية - مع د. عمر عبد العزيز
حاوره/ محمد نعمان الحكيمي
الفيلسوف الناقد العربي الكبير د. عمر عبد العزيز:
نحن محكومون بالجبر، والإبداع بطبيعته دائري!
قراءتي للكتب رأسية، والأثر أفقي.
النقد متفرع من علم الجمال، والفرادة أشبه ما تكون بالعقيق اليماني.
الصفرية والغموض تميمتان سحريتان للوصول إلى اليقين.
توطئة:
بتواضع يليق بالعارفين العظماء الكبار، رحب المفكر والفيلسوف والناقد العربي الكبير د. عمر عبد العزيز بدعوتي له إلى هذا الحوار المباشر الثري بمعرفته وعلومه وفنونه المطبوعة المستمدة من الواحد الأحد الحي الذي لا يموت.
ناقش أسئلتي التي طرحتها على طاولته المزدحمة بمهام كثُر ومسؤوليات متنوعة تكاد تستأثر بكامل وقته؛ لذا كانت أجوبته ارتجالية مباشرة صوتًا ونصًا، حشد الآفاق والأقطار والعوالم فيها، في حين كان الذهول هو الزلفى التي نفذت بي لأطراف أقطاره الإبداعية، والمدد الذي ثبتني وسط هذه الأمواج المعرفية والبروق العرفانية.
كانت البداية بثلاثة أسئلة، لم يكن لدي غيرها: (هل الفن سرقة؟ ما هو الإبداع الأصيل؟ كيف تكون سرقة الفنان؟) وإذا بالأسئلة الكبيرة تنبري لي عند كل أفق شاسع من فضاءات أجوبته، أجوبة فورية صوتية حشدت معارف ناسوتية ولاهوتية وبلا تلكؤ، كنتُ أمامها كطفلٍ غرير أمام كشفٍ نوراني لليلة قدر.
تعالوا نتكشف أسرار وغيوب الإبداع والفن عند هذا العارف الكبير. ناقشنا حقيقة المعرفة، طبيعة التأثر، وميتافوريا الكتابة، وغيرها.
كنتُ كلما حسبت أن حواري معه قد اقترب من انتهاء، عنت لي أسئلة أكثر، ولا تزال ردوده للآن تفتح آفاقًا متجددة من التساؤلات التي أتعطش لمعرفتها، كيف لا وهو د. عمر عبد العزيز الذي استحوذ على أقطار عديدة من المعرفة العرفانية، وآفاقًا واسعة في الفن والنقد وعلم الجمال والأدب والصحافة، ودرس وتفرس آفاقًا علمية وإبداعية رحبة بتمكن وإلمام مذهلين.
هيا نستروح في أمداء معرفته المطبوعة "نستلهمه ونستبصره"، ولكل منا نصيب.
إلى الحوار...
**الإبداع بطبيعته دائري**
هل هناك شيء اسمه فن أو إبداع "جديد"؟
أعتقد أن هناك جديدٌ في الإبداع دائمًا. وفكرة الجديد في الفن هي فكرة فلسفية ووجودية في آنٍ واحدٍ. بمعنى أن الفن بطبيعته دائري، دائري في ما يتعلق بإعادة إنتاج المنتج والأصول المرتبطة بهذا النوع الفني أو ذاك. وهذه الأصول نسميها الأدوات التعبيرية والمدرسية الأوسكولائية أو المدرسية الأكاديمية في الفن، ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن ينقطع الفن في تواتره المتجدد، سواء على مستوى العطاء الفردي أو على مستوى العطاء الجماعي، ومن هذه الزاوية نستطيع أن نتحدث عن دائرة حلزونية تتصاعد أو تتحول أو تتغير، وبالتالي؛ فإن الجديد هو سمة مطلقة في العمل الفني كما هو الحال في الوجود، وهذه السمة تعني إعادة تدوير الذي نعرفه، ولكن بكيفيات مختلفة. وبالتالي؛ فإن من طرائف الفن فيما يتعلق بالتجديد، أنه يمكن كسِّر بعض النواميس المتعارف عليها وتشكُل أيضًا تجديدًا كما فعل "فان كوخ" في المدرسة التأثيرية، وكما فعل "بيكاسو" فيما بعد المدرسة التأثيرية، أو ما سمي بالمدرسة التكعيبية، أو كما فعل "مونش" النرويجي فيما سمي الرسم أو التعبير الفني خارج إطار المرئي والمعروف وهكذا دواليك.
وسأضرب مثلاً في نموذجين استيعاديين لما هو أصيلٌ في الفن العربي، لنرى وجه التفارق بين هذين النموذجين:
النموذج الأول: يتمثل في فرقة محيي الدين بن عربي المغربية التي تعيد إنتاج الإنشاد الديني الصوفي باعتمادٍ كبير على الأداء الهارموني للفرقة، والأداء الفردي الصوتي للمنشد، مع إغفال البعد الإنشادي الكورالي الجماعي، الذي يمثل أصلاً أصيلاً للإنشاد الصوفي، من حيث أنه يسمح بتعارض القرار والجواب تعبيريًا أو بتعددية الأصوات الفردية، من حيث انبجاسها الصادح الفرداني، المقرون بشكل من أشكال الجذبة الصوفية، وهذه القيمة بالذات منحت الإنشاد الصوفي التاريخي قيمًا تعبيرية تمازج بين (التناغم والتضاد)، ومما يمكننا أن نلمحه بطريقة واضحة المعالم في القدود الحلبية.
النموذج الثاني: اشتغال الفنان المصري الشاب مصطفى سعيد على الألحان التراثية بطريقةٍ تمنح القيم الفنية السابقة انزياحات ممتالية صوب التجديد الذي يماهي أنماطًا متعددة في الأداء الفردي والكورالي وتواشجًا حميمًا بين الأصوات البشرية واللحون النغميّة.
مما سبق نصل إلى قناعة راسخة أن التجديد أصل أصيل في الفن، ولكنه صعب المنال. وما ينطبق على الموسيقى ينطبق على الأدب وعلى مختلف الأشكال.
**السرقة هي السطو الواضح المعالم، الحافر بالحافر**
هل ترى أن تحوير فكرة أدبية يمكن أن يكون سرقة؟
في الحقيقة هنالك خيط رفيع أو شعرة تفصل ما بين الانتفاع في الفنون المختلفة سواءً عن طريق الدراسة أو عن طريق النسخ؛ لأن النسخ هو شكل من أشكال الدراسة، أو شكل من أشكال التكشف على أسرار هذا النوع، أو ذاك من الفنون من خلال النسخ أو عن طريق دراسة الفنان نفسه. مثلاً إذا أردتُ أن أدرس تطورات الأبعاد اللونية المتعلقة بالفن التأثيري؛ فيمكن أن أدرس من "سيزان" وأن أتعلم منه، وإن أردت تعلم فنون المناورة في الخط، وهو الخط المقرون بالرسم فهناك "هنري دي تولوز". هذه تجوز، بل إن هذه ضرورة في كل الأنواع الأدبية والفنية، لكن السرقة هي السطو الواضح المعالم وهو أن تؤخذ الفكرة ويتم تحويرها بشكل ما، أو أن يتم أخذ عناصر بنائه كاملةً من لوحةٍ معينةٍ. وبالتالي السرقة والاقتباس بينهما مسافة معينة، تمامًا كالمعارضة في الشعر والبناء على بناء بشكل مطلق (الحافر بالحافر كما يقال) وهذه هي السرقة الأدبية.
نشبه السرقات الأدبية بالسرقات العامة فاللصوص متعددون بتعدد أنماط السرقة: فهناك لصٌ يسرق بقدر حاجته، وآخر يتخصص بسرقة الدواجن، وثالث يقوم بسطوٍ مسلح ويرتكب جريمة، وآخر ينهب من المال العام، وهنالك من يستخدم السلطة لاستباحة الزرع والضرع، وبالتالي فإن تراتب أولئك اللصوص يتباين بتباين أفعالهم، فاللص الاعتيادي ليس كاللص المجرم، والذي يقوم بالنهب المنظم مدججًا بنياشين الدولة ليس كاللص الصغير. وهذه النواميس تجري في الحياة الأدبية والفنية بأشكال مختلفة وأنماط متعددة.
وفي تقديري الشخصي أن المقاصد في كل فعل أدبي أو فني هي التي تؤشر لطبيعة السرقة الأدبية أو الفنية، فالمقصد الناسخ للوحة إن كان التعلُم "مقصد حميد"، والذي يبني على جملة موسيقية عملاً موسيقيًا "مقصده حميد"، وقد رأينا هذا الأمر عند الأخوين الرحباني ومحمد عبد الوهاب. والذي يقوم بمعارضة شعرية لبردة البوصيري كما فعل أحمد شوقي فإن مقصده "نبيل" وشعري بامتياز. والذي يترجم "رباعيات عمر الخيام" بروحية أحمد رامي يقدم نصًا جميلاً على نصٍ جميل.
ومن هنا نستطيع أن نستبين الخيط الفاصل بين الممكن النبيل والمشين غير الحميد.
**التجريب الاستنسابي والمبدع البارع**
من هو المبدع البارع في نظرك؟
المبدع البارع في تقديري الشخصي هو ذلك الذي لا يرضى ولا يقتنع ولا يستسلم لنمطٍ معينٍ أو لأسلوب معين في الكتابة أو في الرسم أو التأليف الموسيقي، بمعنى آخر المبدع البارع هو ذلك الذي يؤصل المُؤَصل ويُجدّد في آن واحد، ذلك هو المبدع البارع. بمعنى آخر أن المعادلة في نهاية المطاف هي معادلة لها علاقة بالتوتّر في الزمان والمكان ولها علاقة بالإبداع بوصفه حالة من التخطي والتجاوزات المستمرة. ولكن هذا النوع من التخطي والتجاوز يتطلب خبرة ويتطلب دراية ويتطلب تشبُّعًا أصلاً وأساسًا وليس مجرد تجريب استنسابي كما يفعل البعض.
وأود في هذه المناسبة أن أدلل على هذا المعنى من خلال قامات أدبية وفنية رفيعة كانوا دائمًا وأبدًا على تماس مع التجريب النابع من فيوض معرفية وإبداعية كما هو الحال مع المخرج الألماني "برتولت بريخت" الذي ابتكر "مسرح التغريب" متخليًا عن الدراما الكلاسيكية المحكومة بمتوالية العرض والعقدة والحل، حيث قام "بريخت" بفتح المسافة الفاصلة بين المسرحية والمتلقي حتى لا يختلط المتلقون في التماهي التام مع النص المسرحي، وهذه المسألة تدل دلالة قاطعة على أن "بريخت" كان يرى في كل أسباب الوجود المقرونة بالمعرفة والإدراك حالةً من التغريب والانحباس في علبةٍ مغلقة. سنرى ذات الحال عند السينمائي الإيطالي "فيسكونتي" والروائي الكولومبي "ماركيز".
**النقد تفريع من علم الجمال**
هل يعد النقد خلقًا؟
أنا شخصيًا أعتمد في مفهومي للنقد ما أسميه بعلم الجمال. وعلم الجمال هو علم من العلوم، وهو شكل من أشكال النقد الشامل، بمعنى آخر أنه يضع بعين الاعتبار سلسلة من الدوائر المحيطة بالنص الكتابي أو البصري أو السماعي. فعلم الجمال يغترف من الفلسفة ومن تاريخ الفن ومن خصوصية كل نوع من الأنواع الفنية والأدبية ومن الأسلوبية التي تُتَّبع في هذا الفن أو ذاك، وتبعًا لذلك فهو تقييم، بمعنى آخر أنه ليس مجرد مجاورة سجالية أو جدلية مع النص الأدبي أو النص الفني ولكنه نوعٌ من التمثُّل الإدراكي والجمالي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تقييم من نوع ما أو إلى مقاربة من نوعٍ ما.
دوائر علم الجمال تمنحنا فرصة لمعرفة التمازجات بين الفنون المختلفة، ذلك أن علم الجمال لا يرى في خصوصية الفن أداةً واحدةً بذاتها، فإذا كان النقد التقليدي يرى الرافعة اللونية في اللوحة التشكيلية، فإن علم الجمال يرى أيضًا في ذلك الموسيقى واللغة المجردة والمفهوم الفكري، وإذا كان النقد التقليدي يرى في المسرح الخشبة والممثلين فإن علم الجمال يرى كل أنواع الفنون في المسرح. وإذا كان النقد التقليدي يعتد بالكاميرا كوسيط تقني في صناعة الفيلم فإن علم الجمال يرى في السينما فنًا للفنون الممزوجة. ولهذه الأسباب مجتمعة تمنحنا النظرة الجمالية للآداب والفنون فضاءات واسعة للتخييل والتجويزات والتجريدات والفراغات.
أنا شخصيًا أعتبر النقد هو تفريع من علم الجمال، وأن علم الجمال مرتبط أيضًا بالجوانب الأخلاقية والجمالية والجوانب المفاهيمية والجوانب السيكلولوجية، مما لا نستطيع أن نجيب عنه في هذه العجالة.
**قراءتي للكتب رأسية تتسم بالحساسية**
هل تحتفظ بما يستأثر باهتمامك من فن أو كتابة تخص مؤلفين آخرين لوقت ما؟ لماذا؟
من حيث الكتب أنا دائمًا أقرأ الكتب قراءةً رأسية وأدون في هوامشها، وأضع خطوطًا، وتبعًا لذلك فإن قراءتي للكتاب تتّسم بنوعٍ من الانتقائية وبنوعٍ من الحساسية تجاه النص المكتوب؛ ولهذا السبب أقرأ بعض الكتب قراءةً مُمعنةً وتفصيلية، والبعض الآخر أمُرُّ عليها مرورًا مسحيًا - إن جاز التعبير – "scanning". وعلى كل حال أنا ألحظ ما أراه متميزًا وجديرًا أن يحتفظ به داخل الكتاب. ونفس الكلام ينطبق على الفنون البصرية والموسيقية بمعنى آخر أنني أجد أشياء مهمةً جدًا في ما يتعلق بهذه الجوانب تستحق أن تكون جزءًا من مكتبة خاصة، ولكن نحن الآن عن طريق الوسائط المتعددة نستطيع استدعاء كل ما نريد أن نراه وفي أي لحظة من اللحظات.
وأنا أعتقد أن المدونة الأشيفية للأفراد المبدعين والكتاب والمفكرين هي مدونة مهمة جدًا لأنه لا أحد ينطلق من عند ذاته ويقول الكلام من ذاته فقط، لا بد من تقاطعات وتراسلات وتناصّات بين المفكرين والمبدعين أينما كانوا.
**أستروح في ظلال ما أحتفظ به**
هل لديك ملف خاص بذلك؟
أنا لا أحتفظ بملف خاص بذاته، لكنني من خلال تصدير الكتب ومن خلال الاحتفاظ ببعض اللوحات ومن خلال الاحتفاظ ببعض النصوص الموسيقية، فهذه كلها اعتبرها ضرورية من آن لآخر، أستروح في ظلالها في لحظات معينة أو زمنٍ معين.
**لا جديد تحت الشمس ومع ذلك هناك جديد**
المقولة "لا جديد تحت الشمس" كيف تقرأها؟
نعم هذه مقولة "لا جديد تحت الشمس"، ولكن أيضًا هنالك جديدٌ، هذه هي المتوالية العجائبية في الوجود والكون، أن كل شيء يعيد إنتاج المُنتَج كما يقال، ولكن في نفس الوقت ضمن انزياح معين. فإذا أخذنا على سبيل المثال الكرة الأرضية، الزمن البيولوجي الذي نعيشه في الكرة الأرضية سنجد أننا محكومون بزمن يومي وهو دوران الأرض حول نفسها، وزمن آخر هو دوران الكرة الأرضية حول الشمس، هذان زمنان نعرفهما، زمن يعطينا اليوم والزمن الثاني يعطينا فصول العام والسنة الكاملة. لكننا لا نعرف الزمن الثالث وهو ذهاب الشمس إلى دورة لا نعرف قصديتها ولا إلى أين ستذهب، وتبعًا لذلك هنالك زمن ينفلت من إطار الزمن الفيزيائي الذي نعرفه.
وعلى هذا يمكن أن نقول أن العالم فيه دوران يعيد تأصيل المؤصل أو تأكيد المؤكد، ولكن أيضًا هناك متجددات منها ما ندركه ومنها ما لا ندرك وهو الأكبر، فالغيوب هي الأساس وهي الأكثر والأكبر.
**ليس هناك قديم بالمطلق**
إذا سلمنا أن الكاتب لا يأتي بشيء جديد تمامًا من عنده، فماذا سيبقى للمبدع من أصالة؟
الأصالة ببساطة شديدة جدًا هي كل ما كان سابقًا ومرسخًا، وهذه الأشياء السابقة المرسخة ليست قديمة في ذاتها ولكن أيضًا تحمل شفرات وتمائم جديدة، لكننا في الأخير وفي التحليل هو حالة تَكشُّف، حتى المستحثات واللُّقى الأثرية فيها تَكشُّف لأشياء يُفاجأ الإنسان بها، فليس هناك قديم بالمطلق، فكل قديم في داخله تمائم سحرية أو تمائم للجديد، وكل جديد فيه نوع من التطيُّر المرتبط بحالة الذهاب إلى رفرفات جديدة في المعرفة وفي الدلالة.
**خدعة الفن**
ما الغرض من خدعة الفن؟
ما يسمى بخدعة الفن أو الفضاء السلبي له علاقة بالسطر الغائب في الكتابة، وهنالك ما لا تراه وما لا تنطقه في هذه الكتابة. نحن على سبيل المثال، في اللغة العربية نكتب بدون صوتيات، أي أن الصوتيات تسعة، هي (الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشد والمد والكسرتين والفتحتين والضمتين)، كل هذه الأشياء ليست مرئية إلا في الرسم القُرآني. وتبعًا لذلك فإن كل كلمة من الكلمات المكتوبة تحتمل بعدًا آخرًا وثالثًا ورابعًا، وتبعًا لذلك فإن فكرة الفراغ الفني هي تلك الفكرة التي تعني أنه لا فراغ، وأنّ هذا الفراغ يحمل في طياته وتضاعيفه مرايا للنص الأصلي سواءً كان بصريًا أو موسيقيًا أو كتابيًا.
ترتبط خدعة الفن بما أسميه المختالة الإبداعية، وهذه المختالة تعني بدقة العبارة "مفاجأة المتلقي بما لا يتوقعه". بل إن المبدع نفسه سواءً كان فنانًا أو شاعرًا أو موسيقيًا قد يُفاجأ بما لم يكن واردًا في ذهنه. وهذا ما يسميه عالم اللسانيات الأهم "نعوم تشومسكي" بالتوليد الإبداعي، كما كان "تشارلز داروين" يسمي (المفاجآت الصدفية في علم التطور البيولوجي للصفات المتنحية) التي تنبثق فجأةً من سلالةٍ ما من السلالات النباتية أو الحيوانية. كما أدرك عالم النفس "فرويد" هذه الحقيقة في الصفات النفسية للبشر وهو ما أسماه باللاوعي بوصفه المحرك المستتر لكثيرٍ من سلوكات البشر. وفي الآداب الآسيوية القديمة وخاصةً عند بوذا وماني وزيرادشت تقترن الهمم العالية بسديم الفراغ، والقوة الحقيقية بالتخلي والتسلي. وهكذا يقول الصوفي:
*عليك يا نفس بالتسليّ*
*فالعز في الزهد والتخلي*
ويقول البوصيري:
*وأكدت زهده فيها ضرورته*
*إن الضرورة لا تعدو على العصم*
بهذه البساطة تلك هي بيناتٌ لمعنى الفراغ والسديم والتحولات في الآداب الإنسانية المختلفة.
**1 + 1 = 3**
(واحد + واحد = ثلاثة) كيف يكون هذا الأمر؟
أنت تسأل سؤالاً له علاقة بالفيزياء الكمومية (واحد + واحد = ثلاثة) كيف يكون هذا الأمر؟
نحن أمامنا فيزياء نيوتن إن جاز التعبير أو الفيزياء التقليدية (واحد + واحد = اثنين)، (اثنين + واحد = ثلاثة). ولكن الفيزياء الكمومية Quantum Physics التي تتكشف يومًا بعد يوم تَخِّل بهذه المعادلات، والحديث فيها يطول.
باختصار، الفيزياء الكمومية كمصطلح عربي مستمد مما يسمى، ومن منطوق المسمى نستنتج الكتلة، والكتلة تنطوي كما نعلم على الكم والكيف، وعندما نتحدث عن الكم والكيف في الكتلة فنحن بإزاء اكتشافات مذهلة لجُسيمات متناهية الصغر مقرونةً بطاقات متناهية الكبر، حتى أن النانو على تضاؤله في الحجم صغيرًا يمنح خياراتٍ لا متناهية في القوة والتكابر، فتصبح المساحة بين الكبر والصغر أقرب إلى العدم.
يقول النفري:
*القرب الذي تعرفه مسافة، والبعد الذي تعرفه مسافة، وأنا القريب البعيد بلا مسافة.*
وكأنه قبل قرونٍ خلت أنبأنا بما ستكون عليه الأحوال في ظل الفيزياء الكمومية التي تتخطى كامل المفاهيم الرياضية والفيزيائية التي عرفناها من قبل.
يقول العلماء أن فتوحات الفيزياء الكمومية ستغير كل شيء في الكرة الأرضية وفي الفضاء الكوني، وأنها ستمنح الذكاء الاصطناعي ما يتجاوزها وستجعل الإنسان العاقل في مهب الريح بعد أن ينشأ كائن هجين، يسمونه الإنسان الهجين، أو بلغة متلطّفة "الإنسان الجديد". وسيكون لهذا الإنسان الهجين خصائص تقنية وبيولوجية مغايرة لما عهدناه في الإنسان العاقل أو الإنسان المعاصر، وسيكون بوسع هؤلاء الناس أن ينقلوا إشارات الكلام عن طريق الماء والهواء دون نطق، وأن تتخاطر العقول وتتبادل الاستشارات والمفاهيم دون مدرسة أو كتاب وما شاكل. إذًا علينا أن نتصور ماذا سيحل بالثقافة والفنون والآداب.
**الوجودي السارتري والتَّرَوْحُن**
يقول كليون: "تسلق الشجرة قدر ما يمكنك، بمجرد بناء شجرتك فقد حان أن يبدأ فرعك الجديد". ما هذا؟
الفكر الوجودي الصادر عن الفلسفة الأوروبية ذات النزعة المادية الجبرية يضع الإنسان في قلب المعادلة الكونية ويستبعد إجرائيًا كامل الرؤى والأفكار الماورائية سواءً كانت دينية أو اجتهادية ممارسية. حتى أن الوجودي "السارتري" يكاد أن يقول "أنا الموجود، أنا الحق، أنا الظاهر، وأنا الباطن" لكنه ليس متصوّفًا بحالٍ من الأحوال، ذلك أن المتصوّف يتروْحن ويرى في ذاته إشارة لا تمنحه الحق في أن يكون مركز الكون.
الجدل الفلسفي النابع من الفلسفة الوجودية بمعناها الأوروبي يفضي في نهاية المطاف إلى مأزقٍ تعانيه الفلسفة الأوروبية وهي الانغماس في العلوم الوضعية والبرهانية حد الانكار للوجود الحقيقي الذي يتجاوز المرئيات والمدركات والمُبرهن عليه علميًا. كما أن الاعتداد بالعلم المحض يفضي إلى غياب المحض على الحقيقة كليًا.
يقول الحلاج:
*عجبت لبعضي كيف يحمله كلي*
*ومن ثقل بعضي ليس تحملني أرضي*
وبالمقابل يقول سارتر:
*عجبت لكلي كيف يحمله بعضي*
*ومن ثقل كلي ليس تحملني أرضي*
**أنت تسأل ما يوازي ردًا في كتاب كامل**
...............................................؟
أود الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية؛ فأنت تسأل ما يوازي ردًا في كتاب كامل. وبالتالي أنا أعتبر أن هذه أسئلة مهمة، لماحة تستحق مني أن أجيب عنها إجابة فيها فيض، وفيها تفاصيل، وأن يكون هذا الأمر مشروع تأليف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجيب عن هذه الأسئلة العميقة المعمقة بهذا الشكل الاستطرادي السهل في هذه العجالة. فالإجابات هنا مبتسرة، والأسئلة لمّاحة وإشكالية تستحق إجابة مطوَّلة.
**الفراغ الممتلئ**
وما الفضاء السلبي؟
بالنسبة لموضوع الفضاء السلبي أو الفراغ بالمعنى الواسع للكلمة، فأنا أحيل القارئ الكريم إلى المراجع التالية: إلى "التاو" الصيني، وهي فلسفة قائمة على ما يسمى بـ "الفراغ الممتلئ". ليس هناك من فراغ وليس هناك فضاء سلبي، هنالك ما يبدو لك فراغًا أو فضاءً سلبيًا كمتلقي أو مشاهد أو سامع، لكنه في حقيقة الأمر يحمل في طياته وتضاعيفه كثيرًا من العناصر الجوهرية والمحركات الجوهرية لهذا التعبير الفني أو ذاك. كما هو الحال على سبيل المثال، بالنسبة للوقفة في الموسيقى أو بالنسبة للبعد الثالث في الفن المنظوري التشكيلي، أو بالنسبة للركح في المسرح.
كل هذه الأشياء تعتمد على فلسفة الفراغ إلى حدٍ كبيرٍ جدًا، ولهذا السبب قلت سلفًا "التاو" الصيني ومضافًا له (رولان بارت) في ما يتعلق بفكرة موت المؤلف. وهذه الفكرة أيضًا وردت عند الشيخ محيي الدين ابن عربي في مقدمة كتابه "الفتوحات المكية"، كما أنها واردة بشكلٍ أو بآخر عند عالم اللسانيات "دي سوسير" وعند "نعوم تشومسكي" فيما يتعلق بالنظرية التوليدية في النص الكلامي.
وفي الحقيقة عندما نتحدث عن اللّسان فنحن نتحدث عن فن، وهو يعني نفس القوانين ونفس النواظم الفنية الموجودة في كل أنواع الفنون موجودة أيضًا في الألسنة البشرية أو في الكتابة أو في الأصوات.
**الفرادة هي أشبه بالعقيق اليماني**
كيف يكون الكائن مزيجاً مما يحيط به ولا يتشكل بهم؟ كيف يمكنه ألا يكون هم؟
نعم هناك قاسم مشترك أعلى بين البشر بالمعنى البيولوجي والسيكولوجي للكلمة، فالناس في تكوينهم البيولوجي أو بأي تصنيف أخذنا هذا التكوين فهم حالة واحدية. ولكن فيما يتعلق بتراكيبهم الداخلية أو المحركات الداخلية لهؤلاء البشر، كل واحدٍ له خصوصيته الخاصة وهو متفرّد.
أنا أشبه الفرادة بالعقيق اليماني، كالمُتَصوِّفة يقولون:
*على العقيق اجتمعنا*
*نحن وسود العيوني*
فكأنهم بذلك يقولون أن هذه الحجرة التي تسمى العقيق كلها من جنس واحد، ولكن ليس كل عقيق يشبه الآخر على الاطلاق. والحال فإن العيون السوداء لا تشبه بعضها بعضًا، لكل واحدٍ بصمته الخاصة. وهكذا الإنسان فهو متفرِّد بكل ما في الكلمة من معنى حتى وإنْ كان ضمن مجموعة من الكائنات البشرية الذين يتحدون في قواسم مشتركة كثيرة.
هذه المسألة تجرُّنا إلى حقيقة إبداعية وهي أنّ هذه الخصوصية أو هذه التميمة الداخلية أو هذا المحرك اللاشعوري هو الذي يخلق التفاوتات في المواهب وفي القدرات وفي الملكات، وهو أمر تمّ بحثه باستفاضة عند "فرويد" وعند "بافلوف" وإلى حدٍ ما كتب عنه المفكر العراقي الراحل "علي الوردي" في كتابه (خوارق اللاشعور) وهو كتاب مهم. لكنه موجود أيضًا في الآداب القديمة عند الغزالي على سبيل المثال في "كيمياء السعادة" و"الإشارات الإلهية" عند أبي حيان التوحيدي، و "الطواسين" للحلاج، وعند فريد الدين العطار في "منطق الطير". بمعنى توجد ظلال لهذه الأفكار في كثير من الكتب القديمة أيضًا.
**ملكات الفنان من نوع خاص**
لماذا اختار الكاتب الأمريكي الفنان تحديدًا كعنوان لكتابه: (اسرِقْ كفنّان)؟
اختار الفنّان لأنه يمتلك حساسية من نوع خاص وملكات من نوع خاص. الفنان بطبيعته لديه أدوات تعبيرية فيها نوع من التّقطير والتهذيب، وتبعًا لذلك فيها قدرة على الإيماء وعلى الإيحاء وعلى الإمالة وعلى الإيهام، وبالتالي يمكن أن يكون هنا سارقًا حقيقيًا كفنان. من هذه الناحية فهي ملكة يتمتع بها هذا الفنان لا أقل ولا أكثر.
**نقطة السديم**
إذا اتفقنا أنه لا يوجد عمل أصيل، فهل قد تكون هناك سرقة أصيلة؟
عمل أصيل، سرقة أصيلة، المهم في المعادلة هذه ليست هذه التعابير، ولكن الحقيقة الوجودية والفلسفية المرتبطة بمعنى الأصالة بمعنى الانطلاق بمعنى الانبعاث.
الأصالة بكل بساطة هي حاله دائرية، فعلماء الجدل الفلسفي ومنهم "كارل ماركس" وغيره من علماء الجدل الفلسفي تحدثوا عن التراكم الكمي والتحول النوعي، وتبعًا لذلك فإنهم تحدثوا عن أنّ أية تحولات هي مقرونة بدرجةٍ أساسيةٍ بتراكم. وهذا التراكم له أشكال متعددة، لكن هذا التراكم ينبعث من نقطة، من نقطة اللامعنى أحيانًا أو من نقطة الفراغ، أو من نقطة السديم أو العماء. وتبعًا لذلك عندما نتحدث عن الأصالة فإننا نضع بعين الاعتبار أنّ الأصالة كالجديد كلاهما قادم من اللامعنى والعدم، وذاهب إلى العدم وإلى اللامعنى. بمعنى أنه قادم من تجريد لا نَسْتَكْنِه وجوهه الجوهرية، وذاهب إلى تجريد لا نستطيع أن نصل إلى أقصاه.
باختصار هذا الموضوع إشكالي ويتطلب توسعًا أكبر وأكثر.
**نحن محكومون بالجبر، لا مفر لنا منه**
أنا لا أؤمن بالفن، أؤمن بالفنانين. يقول مارسيل دوشامب، كيف ترى ما يقوله؟
الفنان "مارسيل دوشامب" من الذين رشّدوا ومارسوا إلى حد كبير ما يسمى بالفنون المفاهيمية أو البنائية أو التركيبية. ولكن مارسيل دوشامب هو أحد الذين صدروا عن الفلسفة الوجودية، بمعنى الفلسفة التي تستغور في الأنا الذاتية باعتبار أنّ كل المسائل مُجيَّرة على الأنا، وهذه قال بها "جان بول سارتر" بشكل موسع في كتابه (الوجود والعدم). ولكنها فلسفة موجودة بشكل أو ظلال لها عند كثير من الفلاسفة مثل (فريدريك نيتشه وأرتور شوبنهاور والروماني إميل سيوران). كل هؤلاء الفلاسفة تحدثوا عن العدمية بوصفها قريرة الحقيقة الوجودية. وتحدثوا أيضًا عن شكلٍ من أشكال خيبة الأمل تجاه الحقائق، ولهذا السبب تمحور بعض منهم وهم الوجوديون على وجه حول الأنا الذاتية وقالوا "إننا نحن الأنا مركز الكون ونحن الذين نصنع الشواهد والمشاهد ونحن نصنع الافتراضات والمعاني والمفاهيم". وانعكست هذه النظريات على الفن التشكيلي وعلى التعابير الفنية البنائية ذات الطابع المفاهيمي الذي يطول الحديث عنها.
يقول مونش: (أنا أرسم ما لا أرى وما لا أعرف) بينما كان بول سيزان يقول: (أنا أرسم ما أرى لا ما أعرف). وهنا نلاحظ أنّ هذا التطور في المفاهيم هو تطور من التجسيم للتجريد، والتجسيم المفاهيمي يتحول إلى التجريد بالتدريج، واحدةً تلو الأخرى حتى يصل إلى التجريد الأقصى. ولكن في نهاية المطاف يرتكس ويعود مجددًا إلى الحقيقة الوجودية الجبرية التي لا مفر للإنسان منها. نحن محكومون بهذا الجبر، محبوسون في نواميسه وقوانينه، وليس لنا فكاك من ذلك.
وعلى المستوى التاريخي العربي للفلاسفة الوجوديين نستطيع أن نقول أن ظلالاً لبعض رؤاهم موجودة عند ابن سينا وعند أبي العلاء المعري وعند ابن الرواندي.
**الأثر أفقي**
هل تترك خطط دروسك في عملك لمن أراد أن يتعلم ويتدرب؟ وكيف يمكن أن ترفض من يريد أن يتعلم منك؟
فيما يتعلّق بالمدرسية والتعليم والتعلم والمنتج سواءً كان منتجًا إبداعيًا أو فنيًا أيا كان، كلهم يعلّمون سواءً كان هذا التعليم أكاديمي أو مدرسي أو بطريقة غير مباشرة. والتعليم الذي يأتي بطريقة غير مباشرة من خلال الذائقة أو من خلال التعلم الشفيف أو من خلال الإعجاب يكون له مرات كثيرة شأن عظيم، لأنه نابع من روح شغوفة بالمعرفة أو شغوفة بتتبع مسيرة هذا الفنان أو ذاك الكاتب؛ ولهذا السبب فإن الأثر التعليمي للفرد هو أثر أفقي متصل بكل روافد الحياة.
مثال بسيط على ذلك: جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي، كان التبريزي شخصية مُتَبَهْللة بحسب المدونة التاريخية ولكنه كان ملهمًا لجلال الدين الرومي في مثنوياته. وعلى هذا المنوال نستطيع أن نقول أن هناك من يتعلمون منك أهم بكثير ممن تدرّسهم في الجامعة أو المدرسة. وأيضًا بالمقابل أن تتعلم بدون حدود، بمعنى آخر الذين يعلمون ويعرفون هم أكثر من يتعلمون ومن كل الناس.
المخرج الروسي سيرجي آيزنشتاين مخرج عبقري هو الذي اكتشف المونتاج السينمائي. وكان اكتشافه للمونتاج السينمائي من خلال دراسته للغة اليابانية. ما علاقة المونتاج السينمائي باللغة اليابانية؟ فهو أول من قام بتقطيع التوليفات الصُّوَرية لكي يقدم قيمة تعبيرية مونتاجية جديدة. لكنه قال بكل بساطة أن اللغة اليابانية هي التي ألهمتني هذا العمل، والذي كان عملاً مبتكرًا في فن صناعة السينما.
**الاستنساخ الإبداعي**
يقول سلفادور دالي: من لا يتأثر لا ينتج شيئًا. ما رأيك؟
ما ذهب إليه سلفادور دالي مهم جدًا، كل فنان في نهاية المطاف لابد أن يتعلم من السابقين. وهذا ما نسميه بالاستنساخ الإبداعي وهو الذي يجعلك تَتَكشَّف على سر التقنيات عند هذا الفنان أو ذاك. وهي حالة أصيلة في المعاهد الفنية، فإذا أردت على سبيل المثال أن تعرف "ديلاكروا" في العلاقة بين الضوء والظل، يستحسن أن تستنسخ "ديلاكروا" حتى تعرف سر التعامل الذكي مع الضوء والظل.
وحتى في التقاليد التاريخية عندنا، الحفظ هو شكل من أشكال النسخ، أو شكل من أشكال التملك الذوقي والجمالي والمعرفي للشعر العربي مثلاً أو القرآن الكريم. فمن لا يحفظ لا يستطيع أن يكون شاعرًا؛ لأنه بحفظه هذا يتعرف على الخوارزميات الصوتية الموسيقية والخوارزميات الشكلية البصرية الهندسية، ويتعرف على الأسرار في اللغة. وبالتالي هنا لا نستطيع أن نقول أنه يقوم بالتقليد ولكنه يؤسس لمعرفة حقيقية، يؤسس لذائقة قادمة. وهذا يجري على كل المستويات.
**قوانين السرقة الأدبية والفنية لابد أن تكون دقيقة**
ما مصير ما يسمى بـ (السرقة الأدبية) في ظل هذا الطرح؟
كما أسلفت هناك خيط رفيع فاصل بين السرقة الأدبية والانتفاع المفاهيمي المعرفي الدلالي للأنواع الفنية. وبالتالي ما كان مكشوفًا وواضحًا واستنساخًا ميكانيكيًا لا يتقصَّد المعارضة أو يتقَصَّد المعرفة أو يعرضه بطريقة مخاتلة؛ يقول أنا رسمت هذه اللوحة مثلاً، وهو لم يرسم الفكرة أساسًا وجوهر العمل، هذه تسمى سرقة أدبية. لابد أن يكون هناك قانون حساس، قانون أدق من بقية القوانين. قوانين السرقة الأدبية والفنية هي قوانين لابد أن تكون دقيقة إلى أبعد الحدود.
**الآلات لا تسرق**
هل استطاعت الآلة سرقة المبدع الفنان؟
الآلات لم تسرق الفنان، الحقيقة أن الإنسان على امتداد التاريخ المعروف كان يغير أدواته المعرفية وأدواته التعبيرية. الذين كانوا يرسمون قبل قرونٍ خلت كانوا يرسمون بألوان وأدوات مختلفة، تغيرت الأدوات وتعددت وتنوعت. والذين كانوا يكتبون بالقلم فاليوم يكتبون بالكيبورد أو لوحة المفاتيح. كل ما في الأمر أن الحساسيات تغيرت وطريقة التعبير تغيرت. وأنا أشبه التطور التاريخي الذي حصل في استخدام أدوات التعبير التقنية المعاصرة تمامًا كفرقة موسيقية تعزف (أوكتاف) واحدًا على سبيل المثال. وهذا الاوكتاف قائم على لوازم لحنية معينة، لكن الذي يستخدم الآلة الوترية غير الذي يستخدم البيانو، غير الذي يستخدم الإيقاع، غير الذي يستخدم آلة النفخ، أو آلة النقر. بمعنى آخر يعبّرون عن هذه الجملة الموسيقية، ولكن كل واحد عنده تقنية خاصة وطريقة خاصة.
فهذه اللغة هي لغة واحدة من حيث الأسس ولكنها متنوعة من حيث الأدوات. وتبعًا لذلك فإن الإنسان المعاصر ستتغير ملكاته ومهاراته باستخدامه للأجهزة الحديثة. وأنا على المستوى الشخصي أرسم كثيرًا عن طريق التطبيقات ولا أشعر على الإطلاق أن هذه التطبيقات تحل محل الفنان بأي حال من الأحوال، بالعكس هي تضعك أمام استحقاقات من نوع جديد، وأمام حساسية من نوع جديد. وتبعًا لذلك نستطيع أن ترسم بها.
كل ما في الأمر أنها توفر عليك عناء استحضار الألوان المائية والألوان الزيتية وألوان الأكريليك وما إلى ذلك. يعني ألوانك موجودة داخل التطبيق، لكن حساسيتك في التعامل مع القلم ومع إصبعك هي ذات الحساسية التي يمكن أن تمارسها في الرسم التقليدي. وأعتقد أن الأمر يجري على هذا النحو. وبالتالي التكنولوجيا غيرت طريقة الإنسان في التعامل مع الأدوات وبالتالي غيّرت حساسيته وطريقة كتابته وطريقة رسمه وطريقة عزفه.
**البراخيليا والفن**
باعتبارك فنانًا وناقداً تشكيلياً، هل يوجد في الفن شيء اسمه "براخيليا" Brachylogy؟ وهل سرقة الأفكار والأساليب يمكن أن نسميه شكل من أشكال البراخيليا باعتبار الاشتباك الذي تتيحه؟
مصطلح Brachylogy يتصل باللغة اللاتينية وتحديدًا عند القبائل الرعوية التي كانت تتحدث بلغات مختلفة، وفي ذات الوقت تقرّب المسافة بين التنوع اللهجوي واللغة المشتركة. ولعل جزيرة مالطا شكلت نموذجًا نمطيًا لهذا النوع من التجسير الموسيقي الدلالي بين المنطوقات المتنوعة. وبالمقابل انعكست هذه الروحية في الكتابة، ليس فقط بوصفها ترجمانًا للأصوات، بل لقابلياتها المرنة في التوسع حينًا والاختزال حينًا آخر. ومن هذا الباب نستطيع تلمُّس أثر هذه المعرفة الممارسية التاريخية على الفنون وتحديدًا على فن التأويل وكتابة اللغة.
السؤال المركب
كنت قد ذكرت آنفاً في إحدى ردودك أن: "نعم لا جديد تحت الشمس، ومع ذلك هناك دائماً جديد". فهل لجوابك صلة بعلم الحقيقة / بالذات المطلقة / بـ (كل يوم هو في شأن) / بخدعة الغموض / بالصفر / بالأفق / بحضرة الإمكان؟
هذا سؤال مركب ينطوي على عديد من المفاهيم، وسأقول بضع كلمات حول كل مفهوم من هذه المفاهيم وعلى النحو التالي:
علم الحقيقة أشمل من علم الشريعة بحسب الشعراني صاحب الطبقات الكبرى. وهذه الثنائية (شريعة/حقيقة) واحدة من سلسلة الثنائيات السجالية الكلامية التي عرفناها في العلوم الدينية بعامة والإسلامية بخاصة، حيث أن مقابلاتها الثنائية تتمظهر في الحكمة والشريعة بحسب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في رسالته الضافية بعنوان فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. ويمكننا استبدال المسميين بالفلسفة والدين، وهو ما تجلى تباعًا وبصورة راديكالية عند شهيد الحقيقة جوردانو برونو وكذا الإصلاحي اللوثري مارتن لوثر الأول. ويمكننا استتباعًا أن نقف على عشرات الثنائيات السجالية التي ما زالت تعيد إنتاج غليانها حتى يوم الدهر هذا.
أما صلة الحقيقة بالذات المطلقة فقد عبر عنه الداراني بنصٍ بسيط واضح قائلاً:
جمع الله شتاتي
وتوالت فرحاتي
وغدا محبوب قلبي
عين ذاتي وصفاتي
أما فيما يتعلق بالغموض فإن أمر استجلاء كوامنه يطول، ولهذا سأكتفي بذكر بعض محفوظات من نصوص الأقدمين التي تناولت هذه الحقيقة الوجودية بوصفها الدرب نحو الوضوح. وأحيل القاريء الكريم مباشرةً الى كتاب عقلة المستوفز للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي ليستجلي كُنْه معنى القديم والعماء الأول الذي تداعى مع الأمر الإلهي (كُن)، فدارت الأكوان دورتها الكبرى ليستحيل الفتق رتقًا، وتنشأ قوتا الطرد والجذب المغناطيسيتين حتى تبحر الأكوان في سرمدية موسيقاها الناعمة للتوازن.
وفي مقاربته الفريدة بعنوان إنشاء الدوائر ستعرف يقينًا أن الصفر قرين الانبثاقة الأولى للهيئة، وأنه قادم من اللامكان واللازمان، وأنه الحامل لجذوة الطاقة اللاهوتية العابرة لمفاهيمنا وتقديراتنا وعلومنا، وأن تلك المثابة تتجلى في كل مظاهر الحياة. قال ابن الفارض:
وما الخلق في التمثال إلاّ كثلجةٍ
وأنت بها الماء الذي هو نابع
وقال الحلاج:
سبحان من أظهر ناسوته
ســـِرّ سنا لاهــــــــوته الثاقــــــب
ثم بـدا في خلـقـــه ظاهـــرًا
في صــــورة الآكـــــل والشــارب
حتى لقد عـــاينـــه خلـقـــه
كلحظة الحاجـب بـالـحاجب
التميمتان السحريتان للوصول إلى اليقين
هناك من يقول أن "الكتاب" هو النقطة (المداد المطلق)، وذلك لاستهلاك سائر الكتب في نفس الكلام، وبدلالة "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب". ما دلالة وسيميائية النقطة، في علم الجمال لديكم؟ وهل هناك ما يربطها بخدعة الغموض أو الصفرية؟
النقطة أساس الأسس في علم الجمال كما هو في كل علم. والشاهد أن النقطة هي المبتدأ لكل هيئة ورسم ودرس، فكل الخطوط التي نعرفها ونعرف أبعادها بوصفها الدرب السالك لتشكيل مختلف الهيئات، كل هذه الخطوط هي في المحصلة محلٌ هندسي لنقطة تحركت في مختلف الاتجاهات. كما أن الدوائر ليست في المحصلة إلا نقطة تكابرت حجمًا لتضعنا في مثابة الدائرة وأسرارها البالغة.
من المعرف اسكولائيًا أن علم الجمال ينبع من دوائر معلومة، أولها دائرة الفلسفة بوصفها المعنية بالكليات التي لا إجابة عليها قطعًا. فالفلسفة تعريفًا ليست إلاّ سؤالاً لا إجابة له. والدائرة الثانية هي تاريخية الفنون في اتصالها بعلوم التوصيف والتصنيف للأنواع الفنية. والدائرة الثالثة تتصل بالنوع الفني الواحد من حيث خصوصياته. والدائرة الرابعة تتصل بالفنون الحرفية الشعبية. والخامسة والأخيرة تتصل بجماليات الحياة والبيئة، وفيها تحضر الأعراف والأخلاقيات والعادات وأنماط السلوك البشري بوصفها روافد لفلسفة الجمال.
مما سبق يمكننا ملاحظة علاقة علم الجمال بكل مظاهر الوجود ببعديه المرئي واللامرئي. وبالطبع الصفرية والغموض تميمتان سحريتان للوصول إلى اليقين.
قال الرائي محمد بن عبد الجبار النفري بلسان الحق:
وقال لي: قع في الظلمة، فوقعت في الظلمة فأبصرت نفسي.
التعريف الميتافوري للكتابة
يقول أدونيس: نحن لا نقبض على الأفق بل نتنسّمه ونستبصره، وما نكتبه هو ما نتنسّمه ونستبصره، وليس المعنى ذاته؟ هل تتفق مع قوله هذا؟
من حيث الأساس لا خلاف حول ما ذهب إليه أدونيس حول تعريفه الميتافوري للكتابة، فهو من المولعين بالتغميض التجريدي الذي يميد به أحيانًا صوب استنتاجات متسارعة. ولي من الشواهد عشرات الملاحظات على نزعته الآثاروية التي تنزلق في مهاوي أحكام القيمة الاستنسابية، وقد بيّنتُ بعضًا منها في كتابي القديم بعنوان فصوص النصوص، ولا أود هنا استعادة ما قد كتبته قبل عقدين من الزمان. أنا هنا لست بصدد المسألة معه لمجرد الجدل البيزنطي، بل أشير إلى أنه وفي معرض تقييمه للثقافة العربية الإسلامية تجاوز كثيرًا الحقائق التاريخية. ولست أنا من يرد عليه هنا بل أترك الرد للمفكر العراقي الراحل هادي العلوي الذي بين تهافت ما ذهب إليه في كتابه بعنوان الصوفية والسريالية معتبرًا الشاعر الفرنسي رامبو صوفيا مشرقيًا.
تنطبق ذات الملاحظات على سلسلة كتبه ابتداءً من فاتحة لنهاية القرن، مرورًا بالثابت والمتحول، وحتى مقدمة للشعر العربي، فزمن الشعر، وأمس المكان الآن.
ما ليس مؤنثاً في الوجود لا يُعول عليه
حديثه عن "لا شيء جاء من لا شيء" في كتابه الصغير اسرق سرقة فنان يتجلى لك أوستن كليون - إضافةً للفلاسفة والكتاب والفنانين العالميين من غير العرب الذين يُستدل بأقوالهم – عارفًا، آخذًا عن المتصوِّفة العرب القدامى: إذا حررت نفسك من النقطة فلن تجد سواك! أو بقول آخر: من ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته. ما سر واحدية الحقيقة عند كل من وصل إليها أيا كان دينه؟
الحقيقةُ واحةٌ، والجبر سباق يشمل الجميع والخيار جبر منظومة باللطف.
يقول ابن عربي للتدليل على ذلك:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
إذا لـم يكـن ديني إلى دينــه داني
وقـد صــار قلبي قـــابلاً كـل صــورة
فمرعى لغـــزلان وديـــــر لـرهـبـــان
وبيت لأوثــان ولعـبــــة طائــــــــــف
والزاك تـــــوراة ومصـحـف قـــــرآن
أديـن بديـن الحـب أنى توجهـــتْ
ركائبه فالحب ديني وإيـمــانــي
وقال أيضًا:
عـقــد الخــلاق في الالـــه عبادة
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه
وقال أيضًا:
أراقـب أفلاكًـا وأخــــــــــــدم بيعـــــةً
وأحـرس روضًــا بالربيع مُنَمْنَما
فطورًا أسمى راع غزلان في الفلا
وطــــورًا أسمى راهــــبًـا ومُـنـجِّـمـا
المرأة كمداد
يقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي: "المرأة مدادٌ لقصيدتي"، يا ترى هل قصد بذلك دواة حبر المعنى؟ ولماذا اقتصر على المرأة وحسب؟
يرتقي الشيخ محيي الدين بن عربي بمقام المرأة إلى الكمال التام، وقد عبر عن ذلك في ديوانه الاستثناء بعنوان ترجمان الأشواق الذي يبدو من ظاهر قراءته غزلاً بواحًا بمحبوبته النظام التي يقول فيها:
طـال شَوْقي لِطَفْلةٍ ذاتِ نَــثْـــرٍ
و "نظــامٍ" ومــنْبـَرٍ وبَـــيـانِ
مــن بنــاتِ الملوك من دارِ فُرْسٍ
من أجلِّ البلادٍ من أصْبهــانِ
هي بِنتُ العراق بِنتُ إمـامـــــي
وأنا ضِـدَّهــا سَليلُ يــمانــــــي
هل رأيتم يا سادتي أم سمعتُـــم
أنّ ضدّيـــــن قَطُّ يجتمِـعــــــان
لــو تَـرانـا بــــــرامــــــةٍ نَتَعاطــــى
أكْــؤسًا للـهوى بغير بنـــــان
والهـوى بيننا يسوقُ حديـثًـــــا
طيّـبًـا مُطْربًــا بغيــر لِســــــانِ
لرأيتُم ما يذهِبُ العقــلُ فيـــه
يَمـَنٌ والــعـراقُ مُعتنِــقــــــانِ
كَذَبَ الشّاعرُ الذي قال قبلي
وبأحجارِ عقلهِ قدْ رَمـــــاني
أيـها المُنْكِـــــح الثّريــا سُهــيــلاً
عَمْركَ الله كيفَ يَلْتقــيـان
هـي شاميةٌ إذا ما اسـتـقلَّـــــتْ
وسهيــلٌ إذا استهل يَمانــــــي
يومئذٍ أنكر المنكرون عليه ذلك الغزل البواح. فما كان منه إلا أن قدّم شرحًا شاملاً وموازيًا للأبيات، ومنه نكتشف مقام المرأة عند الشيخ محيي الدين بن عربي بوصفه مقامًا لتعددية أعيان الممكنات الوجودية. بل إنه يقول ما ليس مؤنث في الوجود لا يعّول عليه، ضمن مصفوفته الباهرة بعنوان ما لا يعول عليه.
الصفات الباراسيكولوجية عند البشر
أيُصنف التخاطر ضمن هذه السرقات وما مصير ما يسمى في الشعر وحيًا في ظل هذا الفهم لحقيقة الإبداع؟
التخاطر من الصفات الباراسيكولوجية عند البشر وتسمى في الآداب العالمية "telepathy"، ومحتواها انتقال الأفكار والخواطر والعاطفة من فرد لآخر. وقد لاحظ علماء النفس الأهمية البالغة للتخاطر في تسيير شواهد المعارف والاتصالات بين الأفراد، كما لاحظوا الأثر العظيم لهذه الطاقة الإيجابية في صلة الأمهات بأبنائهن حتى أنها تحل محل الحبل السري الذي يجعل من الحنين جزءًا من أمه.
لا يمكن اعتبار التخاطر سرقة، فصلة الأخيرة وضيعة جدًا قياسًا بنبل التخاطر وكونه من المحددات النسقية المتوارية وراء الظواهر المخاتلة.
التخاطر صفة حاسمة للاشعور وخوارقه، للماوراء وكشوفاته الباهرة، للإنسان وعوالمه الخفية واللاخفية.
المرهوب والمرغوب
من أين تأتى بأفكارك د. عمر؟ هل كل شيء كتبته أو رسمته اتكأت به على غيرك؟
الأفكار وليدة المعرفة، والمعرفة على نوعين: إما أن تكون مكتوبة ينالها الفرد سالفًا عن سالف، وكتابًا عن كتاب، وهذا ما يسميه الحلاج العلم المرغوب.
وإما أن يكون قادمًا من الحي الذي لا يموت، وهذا ما يسميه الحلاج العلم المطبوع، وهو علم مرهوب.
نحن نستبدل علم الرسوم بالمدرسة، وعلم القول بالموهبة، وفي كل الأحوال يظل المضمون واحدًا.
يقول الحلاج:
العلم علمان: مطبوع ومكتسب
والبحر بحران: مركوب ومرهوب
ويقول السهروردي مخاطبًا المجادلين الكلاميين:
أيّ علم هذا الذي به تحاجوننا؟ لقد أتيتم به رسمًا عن رسم، أما نحن فنأتي به من الحي الذي لا يموت.
ويقول النفري: إن لم تقف على ما لا ينقال، تشتت فيما ينقال.
ويقول أيضًا: إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.
مما سبق أجد الجواب على سؤالكم لي والمتعلق بعلاقتي بالمعرفة. فقد منحني الله أنماطًا مدرسية متنوعة، تداخل فيها الأوروبي بالعربي والتاريخي الكوشي، وتعدُّد اللغات، وعشق الرياضيات، ودراسة الاقتصاد، والإقامة في الفلسفة والفنون.
لكن هذه المقدمات بجملتها منحتني انبثاقات أخرى لا علاقة لها بالبراهين العقلية والمنطق الرياضي الجبري إلا من حيث تنظيم قلق الفكر.
الحلزون الذي يمنحنا الحرية
يرى كليون أن الفنان هو من لديه قدرة على تمييز المناسب والجيد لكي يسرقه ومقدرة على تمييز ما لا سيستفيد منه فيدعه لحاله ولذلك اختار الفنان في عنوانه لكتابه اسرق كفنان، وهو غير ما رأيته أنت في جوابك السابق. تعليقك؟
من المؤكد أن الفنان وفي معرض تعاطيه الطبيعي مع منجزات ومقترحات الآخرين يتأثر بهم ويترنح ضمن أوكتاف موسيقي متوتر يمنحه عديد النغمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الانتقاء والانتخاب والتناص والعشق والمعارضة الإبداعية والتماهي الإيجابي.
هذه التوترات بجملتها تدخل في باب التفاعل الحميد بل الجبري الذي يمر به الفنان أيا كان. حتى أنه يمكن القول تعميمًا بأن كل فلاسفة العالم صادرون عن ذات السؤال، وكل فناني الصور صادرون عن ذات الجملة البصرية على تعددها اللامتناهي.
الحقيقة يا صديقي إنما ندور في ذات الحلزون الذي يمنحنا الخيار والحرية المسيجين بضرورة الجبر. يقول الشاعر:
المــرء في الظــاهــر ذو اختـيــار
والـجــبر بـاطنًا عليه جـاري
وكان من عجـــائب الجـبـــار
أن يجبر العبــد بالاختيـــــار
ويقول آخر:
ليت شعري والعبد ذو إجبـار
وهـو يبـدو في قـالب المخـتــار
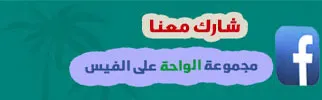
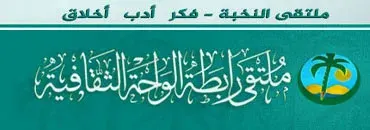



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس