النصّ :
الغرفة موصدة الباب
والصمت عميق
وستائر شباكي مرخاة
رب طريق
يتنصت لي يترصد بي خلف الشباك وأثوابي
كمفزع بستان سود
أعطاها الباب المرصود
نفسا ذربها حسا فتكاد تفيق
من ذاك الموت و تهمس بي و الصمت عميق
لم يبق صديق
ليزورك في الليل الكابي
و الغرفة موصدة الباب
و لبست ثيابي في الوهم
و سريت ستلقاني امي
في تلك المقبرة الثكلى
ستقول اتقتحم الليلا
من دون رفيق
جوعان أتأأكل من زادي
خروب المقبرة الصادي
و الماء ستنهله نهلا
من صدر الارض
الا ترمي
اثوابك و البس من كفني
لم يبل عن مر الزمن
عزريل الحائك اذ يبلى
يرفوه تعال و نم عندي
اعددت فراشا في لحدي
لك يا اغلى من اشواقي
للشمس لامواه النهر
كسلى تجري
لهتاف الديك اذا دوى في الافاق
في يوم الحشر
سآخذ دربي في الوهم
و أسير فتلقاني أمي
الحنينُ إِلى الموتِ
لدى السَّيَّابِ ، قصيدة " فِي الليلِ " أُنموذجاً
" فتكادُ تفيق / من ذلكَ الموتِ ، وتهمسُ بي ، وَالصمتُ عميقْ "
تضيقُ الدنيا بِكُلِّ ما فِيهَا بوجهِ بعضَ البشرِ ، فيبكونَ ويتألمونَ ، وتأخذهم الحسراتُ ، أما المبدعونَ فيعكسونَ ذلكَ الألم وتلك المرارة على مادتهم الإِبدَاعيّة ، وقصيدةُ " فِي الليلِ " هي من قصائد رثاء النفسِ والحنين إِلى الرحيلِ ، فالسيَّابُ يرثي نفسَه ، بِنَصٍّ أَقلُّ ما يُقالُ عنه مؤلمٌ ، فَيشعرُ القارئُ بالدموعِ كيفَ تَغيمُ على القصيدةِ ، وكيفَ تخنقُ مبدعَهَا ، ويعيشُ الحالَ التي يمرُّ بِهَا المبدعُ .
أَجواءُ النَّصِّ مفعمةٌ بالسوادِ ، ابتداءً من العنوانِ والثيابِ السود ، حَتَّى العيش وحيداً بلا رفيقٍ يؤنسه ، أَو يرافقُه رحلتَه : " لَمْ يَبْقَ صَدِيْق " ، وَيجهلُ القارئُ السببَ فِي ذلك ، فَرُبَّمَا يعودُ الأَمرُ إِلى ثيابِهِ ، التي تشبه الفزاعةَ الموضوعةَ فِي البساتينِ لتخويفِ الطيرِ ، وتنذره بالشرِّ إِن تجرأ وتقدّم : " وَأَثوابي كَمُفزّعِ بُستانٍ " وعليه فقد هجرَه الصديقُ ، ويُحتملُ أَن تكونَ الثيابُ هُنا إِشارةً إِلى المرضِ الذي لازمه ؛ ولهذا بقي وحيداً فِي الدربِ حَتَّى يَلقى أُمّه هناك " سَآخذُ دربي فِي الوهم / وَأَسيرُ فَتَلقاني أُمّي " . بعدما أَحكمَ الزمانُ أَبوابَه ، فجعلَ حياةَ الشَّاعِرِ موصدةً ، وقد أَسدلَ الصمتُ راياتِه عليها ، وَخنَقَ كُلَّ أَنْفاسِ الضوءِ والنسيمِ .
صنعَ الشَّاعِرُ حالةً معتمةً ، وهي الحالةُ التي يعيشُهَا خاليةٌ من بصيصِ الأَملِ والحياةِ ، فَكَأَنَّه يئسَ من العمرِ وينتظرُ الرحيلَ ؛ لِهذا كانَ الليلُ حاضراً بِكُلِّ أَبْعَادِهِ ، فَـــ" الغرفةُ موصدةُ البابِ / وَالصمتُ عميقْ " ، هذا المطلعُ يُطالعُنا بعدما نجتازُ العنوانَ مباشرةً " فِي الليلِ " ، فَيَأخذُ بزمامِ الخيالِ ، وَيُدخلُ المُتَلقِّي فِي تلكَ الحال النفسيَّةِ التي يعيشُهَا المبدعُ ، ومن عادةِ السُّكانِ غلقُ أَبوابِ المنازلِ ليلاً ، أَمّا الصمتُ فَتُعلى راياتُه بعدَ هدأةِ الليلِ ، ليخيم القلقُ والترقبُ على المُتَلقِّي .
لَمَّا استَتبتْ الوحشةُ الليليَّةُ على فؤادِ الشَّاعِرِ وآمالِهِ ، فَقد رحلتْ أَنوارُ الأَملِ من قاموسِ مفرداتِ حياتِه ، بَدَأَ يرثي نفسَه ، وجعلَ من الحياةِ وَهماً يرتديه حَتَّى يلجَ فِي نهرِ الحقيقةِ " الموتِ " ، فيقولُ : " ولبستُ ثيابي فِي الوهمِ [...] سآخذُ دربي فِي الوهمِ / وَأَسيرُ فتلقاني أُمِّي " فيلاقي اليقينَ " الموتَ " والقبرَ الذي يحتفظُ بِأُمّه .
كانَ السَّيَّابُ منتظراً على قارعةِ الطريقِ شبحَ الموتِ لينقلَه إِلى " المقبرةِ الثكلى " التي تقطنُهَا أُمّه ، فما تزالُ هناكَ منتظرةً إِيابَه ، وهو بدورِه قد سَئِمَ الحياةَ وحيداً عليلاً مُبعَداً ، فيتمنى اللحاقَ بِهَا : " وَسريتُ : ستلقاني أُمّي / فِي تلكَ المقبرةِ الثكلى " : مقبرةٌ ثكلى تركيبٌ لغويٌّ مستحدثٌ ، الثكلى هي الأُمُّ التي فقدتْ ابنَهَا ، المقبرةُ جزءٌ من الأَرضِ خُصصَ لدفنِ الأَمواتِ ، والأَرضُ هي أُمُّ البشرِ ، فهي ثكلى لأَنَّهَا فقدتْ أَجزاءً وَأَصبحتْ الأَجزاءُ بشراً ، فتنتظرُ هؤلاء أَن يرجعوا إِليهَا .
لا ننسى أَنَّ هناكَ مقولة الأَرض هي أُمّنا الأُولى ، والعلاقةُ بينَ الإِنسانِ والأَرضِ علاقةٌ وطيدةٌ ، ولاسيما مع الشعراءِ ، إِذْ تبدَأُ العلاقةُ مع ( الأُمّ بما هي كذلكَ ، ثم العشيقة التي يختارها الرجلُ على صورةِ الأمّ ، وَأَخيراً الأَرض – الأُمّ التي تستردّه من جديد ) [ التحليل النفسي والأَدب : جان بيلمان نويل : 70 ] ، وقد جعلَ السَّيَّابُ المقبرةَ ثكلى بوصفِهِ ميتاً تفتقدُه المقبرةُ ، أَو بعبارةٍ أُخرى هو واحدٌ من الأمواتِ لكنَّه يقطنُ خارجَ محلِ سُكناه .
ويمكنُ القول إِنّ الأمَّ الحقيقيّة تفتقدُ ابنها الذي تأخرَ مكوثه في الدنيا ، وتُعجِّل له بأن يأتي إليها ، لذا تقول إنّها قد أعدَّت الفراش له ، وإنّ الدنيا قد انتفت منها معاني الحياة ، ولا يمكن أن تصير له موطناً يأويه ويأنسُ به بعد ذلك .
يحقُّ للقارئِ أَن يرى فِي حنينِ السَّيَّابِ إِلى الموتِ ، هو حنينٌ إِلى قبرٍ يضمُّ أُمّه فيشعرُ بِأَنَّ قبرَ أُمّه هو موطنه ؛ لِأَنَّه يعيشُ غربة الوطنِ أَيضَاً – كتب النَّصَّ فِي " لندن " - ؛ ولهذا فلا يخلو النَّصُّ من الحنينِ إِلى الوطنِ ، ولاسيما عندما نعرفُ أَنَّ الأُمَّ كثيراً ما كانتْ ترمزُ لِلوطنِ ، وهذا واضح فِي " الديالوج " بينَ السَّيَّابِ وَأُمّه فِي القصيدةِ ، ويصدقُ القولُ " لقدْ أَرق الاغترابُ الشَّاعِرَ وَنَغصَ عليه حياته ، فَأخذَ يَصبُّ الدمعَ شعراً ، وقد تجمعتْ عليه الرزيا ، وَأَكثرتْ عليه ضروبَهَا " ، فالحنينُ إِلى الموتِ هو حنينٌ إِلى أُمّه الحبيبةِ وَإِلى وطنِه ، فليسَ الحنينُ للأُمِّ وحدها ، وَإِنَّمَا للمكانِ حضورٌ قويّ ، ذلكَ المكان الذي عاش فِيه الطفولةَ ، ولِهذا فالحنينُ مشتركٌ بينهما ، ويدلُّنا على ذلكَ قوله على لسانِ أُمِّه : " تعالَ وَنُمْ عندي / أَعددتُ فراشاً فِي لحدي / لكَ يا أَغلى أَشواقي " ، ويتذكرُ الشَّاعِرُ عبر الديالوج مع أُمّه بعضَ الأَشياءِ التي لازمتْه فِي وطنِه من نهرٍ وصياحِ ديكٍ ؛ لِأَنَّه ابن الريف " جيكور " .
عندها نخلصُ إِلى أَنَّ الحنينَ إِلى الموتِ هو حنينٌ إِلى الوطنِ وَإِلى الأُمِّ الحبيبةِ ، والشَّاعِرُ قد فتقدهما فِي غربته النفسيَّةِ والمكانيّة .
منتظر السوادي - البصرة
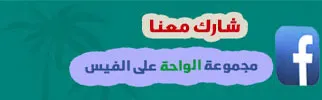
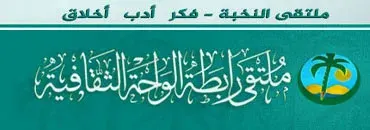



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

