البعد التراثي في شعر محمد إبراهيم الحريري(1)
قراءة في ديواني :( أيها الراحل فالقلب هنا) ، و(في زمن الجنون)
قبل البدء بهذه القراءة أود أن أطرح مجموعة أسئلة بين يدي البحث ، وهي :
هل من الضروري أن يكون الكاتب مؤسسا تراثيا، والى أي مدى يكون ذلك ضروريا في النصوص الحديثة؟ و هل للنص ذاكرة؟ ومن أين يستمدها؟
إننا أمام ظاهرة واضحة المعالم في شعر محمد الحريري الذي يقبض بقوة على جمرة الإبداع، ويختار في كل ما يكتب أن يخرج شحناته وأسراره لتحيا على الورق سعيا لنيل نشوة الدهشة المتمثلة بـ(الخصوصية)و(التعب ير عن الذات)، ومن هنا كان شعره جسرا من الصمت نحو اندياح البوح والتعبير عن الذات.
• توظيف الموروث التراثي في شعر محمد الحريري
توظيف الموروث في النص الشعري العربي المعاصر مسألة في غاية الأهمية، فما من شاعر عربي معاصر معروف إلا ووظف الموروث التراثي في أعماله،وشاعرنا مسكون بالتراث ، بل إنه يتشكل عنده نظاما خاصا داخل بنية الخطاب الشعري ، وقد يبدو هذا النظام عصياً على الضبط والتحديد، وذلك لكثرة ما يأوي إلى الماضي ليستلهم منه الرؤية البديلة عن الواقع ، وعندما نستحضر الموروث في شعره ، فإننا نستحضر التاريخ متداخلا مع الأسطورة ؛ ولذا فإنه يصعب علينا تلمس أوجهها كاملة، وذلك لتناصها مع الحقول المعرفية الأخرى،العربية بنماذجها العظيمة ، و التاريخية بعالميتها . ويظل الموروث ممثلا لبنية معرفية عميقة تتعلق بمعتقدات وروحانيات وأعراف وتقاليد تربى عليها ورضعها منذ نعومة أظفاره إلى جانب أنها تفعل فعلها في تاريخنا المعاصر؟ إنها مزيج من هذا وذاك، ومع ذلك تبقى عصية على الضبط والتحديد، لأنها رؤية متنامية متشعبة في بنية الزمان التاريخي، بل والمكان خارج حدود زماننا. وقليلون هم الشعراء الذين استطاعوا ضبط الموروث ضبطا دقيقا، ولذا نلاحظ غموض النصوص الشعرية التي تناولت الأسطورة والخرافة وبعض النماذج العظيمة في التاريخ البشري، بحيث لا يعادل غموضها إلا غموض النص الإبداعي نفسه.و الشخصيات التاريخية التي يستدعيها في شعره لها بعدها الإنساني، ومدى تأثيرها في شعره يفعل فعله بما يفوق حد التخيل أحيانا على مستوى الفن والأدب، فهي تشكل رؤية جمالية، وظفها شاعرنا توظيفا لا يشبهه فيه أحد، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
الموروث التراثي عند شاعرنا يمثل الملاذ الأول له للانتصار على خيباته ولتخطي فواجعه، وسياسيا كانت محاولة لخلق بديل جديد، أكثر إشراقا وجمالا. إنها البؤرة التي يرى منها شاعرنا النور والفرح؛ لأنها تشكل له حالة توازن نفسي مع محيطه ومجتمعه، فبواسطتها تتم عملية الحلم والتخيل والاستذكار. وبالرغم من التحليلات الاجتماعية والفكرية التي تؤكد أن اللجوء إلى الموروث هو هروب من مواجهة الواقع، وهو دعوة لسيادة الظلم، ودعوة إلى إلغاء العقل: «فالفكر الأسطوري القائم على أساس غيبي ـ لا عقلاني.. له منطقه المختلف تماماً عن منطق الفكر الموضوعي. والصورة التي ينقلها الموروث تنزع دائما إلى إضفاء صفات قدسية غامضة على مواضيعها وأشيائها، وأشخاصها، أقول بالرغم من هذا الذي ذكرته إلا أننا نجد الأمر يختلف عند شاعرنا.فها هو ذا في حديث الفجر يستدعي الموروث لكون موضوعه من الموضوعات التي يستحب فيها العودة إلى الماضي بما فيه من ألق وعظمة أمام خيبات الحاضر:
فحين يتحدث عن كلام العرب الرنان الذي لا يملكون غيره يقول :
فأطفل القول في سفر العنا خطبا بتراء خلطتها من طينة النزق
ولم يكتف هنا باستدعاء الخطب العربية القديمة ، بل جاء بنوع مشوه منها وهو الخطبة البتراء ؛ ليوحي للمتلقي أن هذا الكلام لا يبدأ بالبسملة ، وإيحاء البتراء قد ينسحب على المعنى العام ، لا على المعنى الخاص.
وحين يتحدث عن زوج الشهيد الرنتيسي فإنه يستدعي الموروث القرآني:
فكنت أصدق تعبيرا وملحمة تقريك بالجهر فخرا سورة الفلق،
وهو هنا يقارن بين خطابين : خطاب عقيم ، ويقصد به خطاب العرب المعاصرين ( البتراء)، وخطاب الصدق فعلاو قولا المتجسد ببطلة قصيدته – إن صح التعبير- ، حتى إن سورة الفلق تجهر فخرا بها.
وعندما يريد الحديث عن ذل العرب ، يدعوها إلى الانطلاق ، وهنا يستدعي خطبة الحجاج المشهورة ، ويشير إليها إشارة سريعة دون الولوج في تفاصيلها ، فيأتي بكلمات منها ، وهي المشهورة بكونه يعرف مسبقا أنها معروفة للناس، وهي إشارة لطيفة وفق فيها أيما توفيق:
ها قد رأيت رؤوس الذل يانعة فاستوثقي خطبة الحجاج وانطلقي
ويبقى استدعاء ( سجيل ) من الموضوعات المطروقة جدا في الشعر العربي في الحديث عن الحجارة ، ولكنه وظفه توظيفا موفقا بقوله:
واستنهضت همم الأحجار يسعفها سجيل طائرها في ساحة الطلق
طيرا أبابيل تملي جيش أبرهـــة غلا تنمطق بالسجيل والصعق
وأجمل ما جاء من موروث تراثي استدعاؤه ( لعاد ) في الحديث عن خواء الحكام ، والذين يبنون أمجادهم على آهات الناس وآلامهم، فيقول:
ونراه في لسان الأمنيات يستدعي صورة الأطلال في الجاهلية ، وما ذلك إلا لكونه يرى واقعه وقد بات أطلالا ، تمر عليه الكرامات مرور من يتحسر :
كمثل عاد بنى أحجار سطوته من حشرجات وهاد الضيم والعوق
ترثي أثافي وجدها جدر اللوى نارا تسعر بالهبوب جهاتها
بدموع أشجان المضارب نغتدي وتروح أرسان على صهلاتها
ما بين أنت وأنتما وأنا وذا طلل تلوح كوشم لحد رفاتها
والأروع من ذلك أنه يستدعي التراث في هذه القصيدة بطريقة التناص ، واستدعاء بعض عبارات القصائد، فهو التائه في واقعه يبحث عن شط نجاة ، فلا يسعفه بحر ( الخليل) وهو يقف عند شاطئه، ويقصد بذلك الشعر ، ويضيع بين عبلة والهوى في: (هل غادر الشعراء)...، ويرنو إلى: (ولقد ذكرتك) ، ويمعن في استدعاء الموروث المعروف للناس ، فيلمح أسياف ابن برد ، وذكرى حندج ، في:( قفا نبك) ، ويبكي مالك ، وأبا نواس في (عاج الشقي) ، ويلزم قافلة المعري ، ويرى ابن زيدوزن يكتسي )(نهج التنائي)، ثم يأتي قيسا الذي يلوح بالجنون برداء ليلى ، وهند نراها في ديار الخنساء في عكاظ صخر ، ويعود بنا إلى هاجر وسعيها ... وهكذا حتى يمعن في استدعاء التراث وكأنني به يلهث بحثا عن ماض يعيد له تلك القيم الضائعة في إشارات سريعة وذكية :
نامت سبايا الصبر فوق جفونها ثكلى السهاد بعتمة كسباتها
ترثي آثافي وجدها جُدُرُ اللوى نارا تُسَعِّر بالهبوب جهاتها
بدموع أشجان المضارب نغتدي وتروح أرسان على صهلاتها
ما بين أنتَ وأنتما وأنا وذا طلل تلوح كوشم لحد رفاتها
وإذا مفاوز غربتي أَنِسَتْ بها أسرابُ حيف تصطلي بفلاتها
لا بحر لا ملاح ، أُسْرِجُ وحدتي (بعسى ) هروبا من ضنى عبراتها
لا شطَّ من بحر الخليل يرومني وأنا المهرب من جدار نجاتها
متسللا حدَّ الظنون على مدى أفق المعنَّى من لظى أبياتها
ما بين عبلة والهوى (هل غادر ال شعراء من متردم ) بوشاتها
أرنو إلى ( ولقد ذكرتك والرما ح) تبرجت في خدرها لصلاتها
ولمحت أسيافَ ابن ِ برد ٍ كالضحى يَبْسُمْنَ مجد ا من علا شرفاتها
أوقفت غيد الصبر (ذكرى حندج) عند (الغدير) ( قِفا ) على عرصاتها
نبكي أنا والليل (مالكَ) سائلا خطَّا لناظرة السها زفراتِها
ورأيت أسراب الندامى تغتدي لنواسها ( والطير في وكناتها)
( عاج الشقي) (إذا المنية أنشبت بتميمة ) فأتى بها حاناتها
( ولزمتُ ) قافلة المعري ما بدا ضر يندي باللمى
هذا ابن زيدونَ بأضحى يكتسي نهج التنائي بردة ً لثباتها
( يا صاحبي تقصَّيا ) فأنا هنا في أمة كشفت ( قَفَا) سوءاتها
فأتيت قيسا بالجنون ملوحا برداء ليلى في دعا صلواتها
وإذا بهند في ديار تماضر بعكاظ صخر صفقوا لوفاتها
وأنا أهيم (كهاجرٍ) سعيَ الفدا سبعا أطوف ببئر طهر صَفَاتِها
بمفازة الأحلام أنحر آهتي
بالغيب أرجم كل ظن مثقل بيراع وصل من عتاق دواتها
ومضيت أبحث عن صدى أحلامنا فإذا بها تشكو سدى علاتها
وهويتي ضاعت بدهليز الأسى رسما يحوم على ثغور شتاتها
أخطو فيسبقني العثار على الخطى فأخط سطرا باعتراف جناتها
جدران صمت تستبيك بزفرة ثكلى المواجع من عسيس ولاتها
أشتق من كلم التقصي دهشة عذراء ما جس الأنين سُماتِها
وتعنست بجوى المعاني حيرة لم يدرك المكيالَ صاعُ ثَقَاتِها
إني أرى يَنَعَ الرؤوس تطايرت وابن الجلا قذفا بثكل حصاتها
وتلُومُني ضادُ الكناية والمدى أقمار إفك غيروا
وأنا أفتش مفردات
أعيت مهارَ الذكريات جوانح أورت شموع الجان من عبراتها
وكأنها أقداح أصداء المنى
صهباءَ من شجن العواذل جادها كأس الإجابة من رحاق زكاتِها
فترنحت شفة الضمير إنابة قبل استلام كرى المدام عظاتها
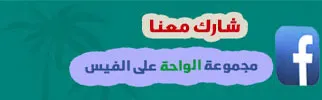
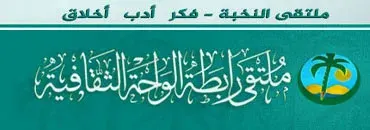




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس







